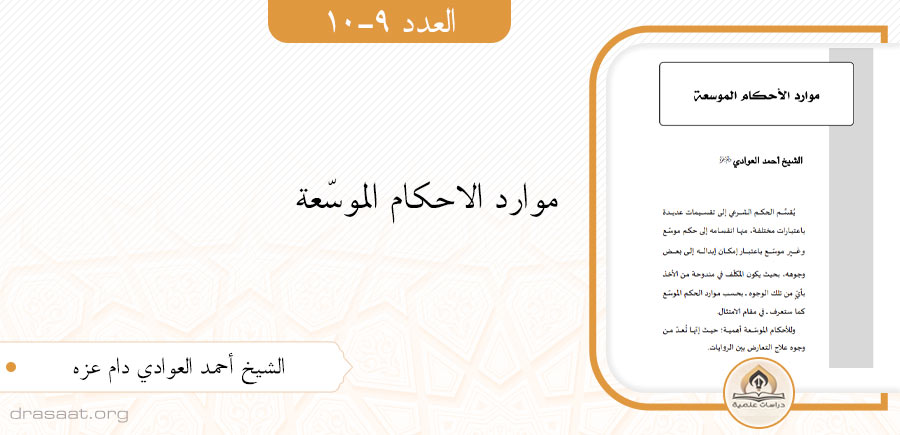
موارد الاحكام الموسّعة
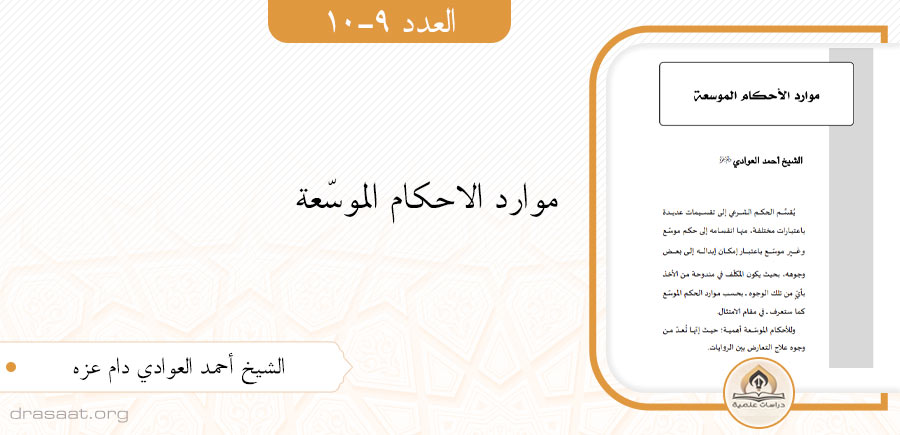
احدث المقالات
موارد الأحكام الموسّعة
الشيخ أحمد العوادي (دام عزّه)
يُقسَّم الحكم الشرعي إلى تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة, منها انقسامه إلى حكم موسّع وغير موسّع باعتبار إمكان إبداله إلى بعض وجوهه, بحيث يكون المكلّف في مندوحة من الأخذ بأيٍّ من تلك الوجوه ـ بحسب موارد الحكم الموسّع كما ستعرف ـ في مقام الامتثال.
وللأحكام الموسّعة أهمية؛ حيث إنّها تُعدّ من وجوه علاج التعارض بين الروايات.
المقدّمة
بسم الله الرحمن الرحيم
يُقسَّم الحكم الشرعي إلى تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة, منها انقسامه إلى حكم موسّع وغير موسّع باعتبار إمكان إبداله إلى بعض وجوهه, بحيث يكون المكلّف في مندوحة من الأخذ بأيٍّ من تلك الوجوه ـ بحسب موارد الحكم الموسّع كما ستعرف ـ في مقام الامتثال. وللأحكام الموسّعة أهمية؛ حيث إنّها تُعدّ من وجوه علاج التعارض بين الروايات, ولكي يتّضح موضوع البحث ـ موارد الأحكام الموسّعة ـ سنُشير إجمالاً إلى أقسام التعارض, وأقسام الجمع الدلالي تمهيداً للبحث.
أقسام التعارض: وينقسم التعارض إلى قسمين:
القسم الأوَّل: التعارض غير المستقر: وهو الذي ينتهي إلى اكتشاف جمع دلالي بين الدليلين ينكشف به المراد الجدي بهما, ويكون ذلك في حال وجود مرجّح دلالي لأحد الدليلين قرينةً عرفاً على المراد بالآخر .
القسم الثّاني: التعارض المستقر, وهو الذي لا ينتهي بجمع دلالي مقبول بين الطرفين فيؤدي إلى تكاذب الدليلين جهة وصدوراً.
أقسام الجمع الدلالي:
وللجمع الدلالي بين الدليلين الرافع للتعارض بينهما نكاتٌ عديدة، منها حمل أحد الدليلين على كون الحكم فيه موسعاً, أو حمل الدليل الآخر على كون الحكم فيه مضيقاً.
وبهذا الاعتبار ينقسم الجمع الدلالي في حالات التعارض غير المستقر إلى ما يُنتج كون الحكم في المورد من قبيل الأحكام الموسّعة. وما لا يُنتج ذلك فيجري في مورد كون الحكم من قبيل الأحكام المضيّقة.
وهذان القسمان بالحقيقة هما نحوان من الجمع الدلالي يختلف فيهما مبنى الجمع ومُصحّحه, كما يختلف مصحّح صدور الكلام الذي يحمل على الكلام الآخر.
وأوَّل من تعرّض لهذا البحث بهذه الصيغة ـ وهو تفاوت الجمع الدلالي وحيثياته في الأحكام الموسّعة وغيرها ـ سماحة السيد السيستاني F في بحثه الشريف(١) حول تعارض الأدلة الشرعية عندما تناول في هذا البحث أسباب الاختلاف والكتمان الناشئ من المعصومين i, ناقلاً التنبيه على أصله عن العلّامة الميرزا مهدي الأصفهاني من أجلّة تلامذة المحقّق النائيني S.
المراد بالأحكام الموسّعة
الحكم الموسع: هو الحكم الذي يكون في مورده نحو توسعة تتيح إبداله عن وجهه الأصلي تارة. أو البناء على بعض وجوهه أخرى، ويشمل ذلك حالات عديدة:
١ـ أنْ يكون الحكم الواقعي ترخيصاً مقروناً برجحان أو مرجوحيّة من غير إلزام،
فيمكن أنْ يرد بعض الأدلة في هذه الحالة بمحض الترخيص, ويرد بعضها ببيان الرجحان أو المرجوحيّة على ما هو عليه من عدم الإلزام، ويرد بعضها الآخر على وجه ظاهر في الإلزام دفعاً للمكلف إلى الأخذ بالفضل, أو لغيره من الأغراض الآتية.
٢ـ أنْ يكون الحكم الواقعي وجوباً متعلّقاً بالطبيعة, فيكون المكلّف مخيّراً عقلاً بمقتضاه بين حصصه، فيرد بعض الأدلة بالأمر به حسب وجهه الواقعي, بينما يرد بعضها الآخر بالأمر بحصة منه لفضيلة فيها, أو لنكتة أُخرى.
٣ـ أنْ يكون الحكم الواقعي وجوباً تخييريّاً بين عدّة خصال فيرد الأمر على وجهه في بعض الأدلة, ويرد الأمر ببعض الخصال لفضيلة, أو ملائمة مع حال سائل آخر. وقد يتفق أنْ لا يرد الأمر التخييري بين الخصال في شيء من الأدلة, وإنَّما يُستكشف من الأوامر المتوجّهة إلى الخصال جمعاً بينها .
٤ـ أنْ يكون الحكم الواقعي وجوباً موسّعاً, فيرد الأمر على وجهه في بعض الأدلة, ويرد الأمر بالواجب في أوَّل الوقت أو غيره لفضلٍ, أو نكتة أُخرى.
٥ ـ أنْ يكون الحكم الواقعي وجوباً كفائياً, ويرد الأمر على وجهه في بعض الأدلة, ولكن يوّجه إلى بعض المكلفين لنكتة خاصّة في المورد.
ولا تختصّ الأحكام الموسّعة بالأحكام التكليفيّة, بل تشمل الأحكام الوضعيّة, فقد يكون الحكم الوضعي مقتضياً للتوسعة كالطهارة, فيرد الدليل به تارة. وبالتضييق أخرى, من جهة درك فضيلة, مثل استحباب التطهير كما قيل في الأخبار الآمرة بالنزح من البئر عند وقوع النجاسة فيه.
وهكذا نلاحظ أنّ الجمع الدلالي في هذه الموارد لا يكون لصرف النظر عن مدلول أحد الدليلين رأساً؛ لعدم كون ما فيه بياناً للحكم الواقعي على نحوِ ما يتحقّق في حمل العامّ على الخاصّ, حيث يُحمل العامّ على أنّه ليس مسوقاً لبيان الحكم الواقعي أو وجهاً من وجوهه في مورد الخاصّ, وإلّا سيق في مقام تعليم القاعدة العامّة, بل كلٌ من الأدلة في هذه الموارد ناظرٌ إلى الحكم الواقعي: إمّا بجميع وجوهه, أو يكون بعضها مُصحّحاً لذكرِ الحكم لا على وجهه في مورد الأحكام الموسّعة.
ثُمّ إنّ موارد الجمع بين الدليلين هي الموارد التي يكون الحكم في بعضها موسّعاً، فإنّ ذكر الحكم على بعض وجوهه ـ لا على وجهه الواقعي بحدّه لأغراض خاصّة ـ لا يُجزي مثلها في موارد الأحكام المضيّقة:
منها: السّوق إلى الكمال, فإنّ الزعيم الموجِّه للجماعة والمتصّدي لسوقهم إلى الكمال, قد يقتصر على بعض أفراد الواجب التخييري فيما إذا كان ذلك البعض أفضل، كما في العتق في كفارة الإفطار في شهر رمضان، فالشخص يذكر للإمام gأنّه افطر متعمداً في شهر رمضان, فيأمره الإمام gبعتق رقبة؛ لأنّ العتق أفضل أفراد الواجب التخييري، أيّ أفضل من إطعام ستين مسكيناً, أو من صوم شهرين متتابعين.
ومنها: الرفق بحال السّائل كما في الأمر بذبح شاة في بعض كفارات الحج, مع أنّ الكفارة مخيّرة بين الشّاة والبقرة والبعير, ولكن رفقاً بحال السّائل من جهة كونه فقيراً يأمره الإمام g بذبح الشاة من دون ذكر باقي أفراد الواجب التخييري .
ومنها: إيقاع الخلاف بين الشيعة ليعطي انطباعاً للسلطة الغاشمة أنّ الشيعة ليسوا بجماعة موحَّدة وموجَّهة من قيادة واحدة, بل لهم قيادات متعددة ولذلك فهم يختلفون فيما بينهم حتى في أداء عبادتهم, فيدفع الإمام g عن نفسه وعن شيعته الأذى. وقد تنبّه إلى تأثير هذا العامل في اختلاف الأحاديث صاحب الحدائق حيث ذكر في الحدائق: (فصاروا صلوات الله عليهم ـ محافظة على أنفسهم وشيعتهم ـ يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإنْ لم يكن بها قائل من المخالفين)(٢) .
وقد ذكر السيد السيستاني F في بحثه الشريف حول إيقاع الخلاف بين الشيعة: (إنّ وجود الرقابة الشديدة على الأئمة i وشيعتهم في تلك الفترة كانت تفرض وجود بعض الاختلافات الشكلية والصورية في الأحكام فيما بينهم, فإنّ اتفاق كلمتهم على الحكم سيكشفهم للسلطة ويكشف انتسابهم للإمام g, وسيعرضهم لمخاطر كان من الممكن تفاديها بإلقاء الاختلاف بينهم في الأحكام التي لم تكن بتلك الدرجة من الأهمية)(٣) .
ومثل ذلك إيقاع الخلاف بينهم أحياناً وقاية للإمام gعن أنْ يُطعن عليه من قِبل عموم الناس, أو علمائهم فيما تختلف فتاواهم عنهم, وقد ذكر السيد السيستاني F : (ومن هنا نجد أنّ الإمام الباقر والصادق h على الرغم من تبنيهما مذهباً فقهياً يخالف ما عليه العامّة, لكنّهما يتمتعان بالوثاقة والاعتبار والمكانة المحترمة عند العامّة, مع أنّ عادة العامّة الجرح لأدنى سبب, فإنّهم حين يرون اختلاف الشيعة فربّما نسبوا ذلك للشيعة أنفسهم لا إلى الأئمّة i, فيتصوّرون أنّ الأئمّة i لا يخالفونهم وإنمّا الخلاف جاء من الشيعة أنفسهم. ويشهد لذلك ما جاء في الكشي ونقله عنه في رجال المامقاني عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، وقد تُرجم في كتاب (ميزان الاعتدال للذهبي) قال: i قلت لشريك ـ وهو من العامّة ـ إنّ أقواماً يزعمون أنّ جعفر بن محمّد ضعيفٌ في الحديث؟ فقال: أُخبرك القصة كان جعفر بن محمّد رجلاً صالحاً مسلماً ورعاً, فاكتنفه قومٌ جهّال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدّثنا جعفر بن محمّد, ويحدّثون أحاديث كلَّها منكرات كذب موضوعة على جعفر, يستأكلون الناس بذلك ويأخذون منهم الدراهمi ـ إلى أنْ قال ـ فنجد أنّ التغطية التي كان يهدفها الإمام من خلال إلقاء الخلاف بين الشيعة قد تحقّقت بالفعل)(٤) .
ومنها: مداراة الأئمة i لبعض الشيعة ممّن كان قليل التحمّل لبعض الأحكام, أو للتقيّة من العامّة كما سيأتي في مورد أمر الإمام g بالصلاة تامّة في المسجد الحرام, وقد ذكر السيد السيستاني F في بحثه الشريف حول المداراة مع السائل: (قد يكون السائل من أهل الولاية, ولكن نتيجة لبعض العوامل لا يكون بمستوى تحمّل معرفة الحكم الواقعي, كما لو كان يعيش آراء المخالفين, أو كانت مرتكزاته محكومة بالتبليغ المضاد للحكم الواقع, أو لاشتهار الحكم المخالف بحيث يستغرب من الرأي الجديد ونحو ذلك ممّا يستوجب عدم إمكان التصريح له بالحكم الواقعي ومواجهته به، فربّما أدّى ذلك إلى تشكيكه في معتقداته الحقّة)(٥) .
إذا عرفت ما تقدّم فلندخل في أصل البحث حول الدليل على كون التوسعة سبباً في تعارض الأخبار, وينبّه على هذا الأصل العامّ في سبب تعارض الأخبار والجمع بينها بحملها على كون الحكم موسعاً مجموعتان من الروايات:
إحداهما: عامّة, تنبّه على هذا المعنى بنحو كليٍّ وصريح, إذ تدلّ على أنّه متى كان الحكم موسعاً فقد يتكلم الإمام g ببعض وجوهه في بعض الأدلة, وببعضها الآخر في آخر منها.
والأُخرى: موارد خاصّة تعارضت فيها الروايات، دلّ بعضها على أنّ كون الحكم موسَّعاً هو أساس الاختلاف.
وهناك مجموعة ثالثة وهي الموارد التي تختلف فيها الأخبار, وتُخرّج على أنّ منشأ الاختلاف توسعة الحكم في المورد لا لدلالة بعض الأدلّة فيه على ذلك صريحاً, بل من جهة إعمال موازين الجمع بين الدليلين, وهذه المجموعة كثيرة من أوَّل الفقه إلى آخره. ولا حاجة إلى ذكرها أو ذكر شيء منها.
الأدلة العامّة
ونذكر منها ما ورد في معتبرة عبد الأعلى بن أعين قال: سأل علي بن حنظلة أبا عبد الله g عن مسألة وأنا حاضر فأجابه فيها، فقال له علي: فإنْ كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر، حتى أجابه بأربعة أوجه، فقال علي بن حنظلة: يا أبا محمّد هذا باب قد أحكمناه، فسمعه أبو عبد الله g فقال: (لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنّك رجل ورع, إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة وليس يجري إلَّا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس وقتها إلَّا حدّ واحد، حين تزول الشمس، ومن الأشياء أشياء موسّعة تجري على وجوة كثيرة وهذا منها، والله إنّ له عندي لسبعين وجهاً)(٦).
والكلام تارةً في سند الرواية. وأُخرى في دلالتها:
أمّا السند فقد وردت الرواية في كتاب المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي ـ وإليه يرجع ضمير (عنه) في أوَّل الإسناد ـ عن أبيه وهو محمّد بن خالد البرقي، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين.
وإسناد الرواية صحيح.
أمّا أحمد بن محمّد البرقي صاحب كتاب المحاسن فقد وثّقه النجاشي والطوسي (٧). وقال عنه ابن الغضائري: (طعن القميّون عليه، وليس الطعن فيه, وإنّما الطعن في مَنْ يروي عنه)(٨). وهو من الطبقة السابعة.
أمّا محمّد بن خالد البرقي فهو قميّ والد صاحب المحاسن, وثّقه الشيخ(٩) , إلَّا أنّ النجاشي ضعّفه(١٠) . ولكن التضعيف غير ظاهر فيه, بل لا يبعد أنْ يرجع إلى حديثه لأنَّه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، وعن ابن الغضائري إنّه يعرف وينكر(١١).
وهذا الكلام أيضاً لا يمثّل قدحاً في الرجل؛ إذ يجوز أنْ يكون إنكار بعض ما رواه من جهة ضعف من روى عنه. وعليه يكون توثيق الشيخ له بلا معارض. وهو من الطبقة السادسة .
وأمّا علي بن النعمان فهو النخعي الكوفي ثقة، ثبت، وجه صحيح واضح الطريقة، كما عن النجاشي(١٢). وهو من السادسة.
وأمّا عبد الله بن مسكان فهو كوفي وثّقه الشيخ(١٣) . وقال عنه النجاشي ثقة عين (١٤).
وعدّه المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام الذين لا مطعن عليهم (١٥) . وعدّه الكشي من أصحاب الإجماع(١٦) . وهو من الطبقة الخامسة.
وأمّا عبد الأعلى بن أعين العجلي فهو كوفي, قال عنه الشيخ المفيد S في رسالته العددية أنّه من فقهاء أصحاب الصادقين h, والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفُتيا والأحكام الذين لا يُطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم, وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنّفات المشهورة (١٧) . وهو من الطبقة الخامسة.
ولو نوقش(١٨) في وثاقته لمجرّد ورود اسمه في العبارة المتقدّمة للشيخ فيمكن توثيقه من خلال رواية صفوان عنه, لأنّ عبد الملك بن أعين هو نفسه عبد الأعلى الذي يروي صفوان عنه.
وبهذا تكون الرواية معتبرة لعدم وجود إبهام, أو ضعف في حال أيّ رجل من رجال سند الرواية.
وأمّا البحث عن دلالة المعتبرة فالظاهر أنّ المراد من قوله g: (من الأشياء أشياء موسّعة) ، أنّ من الوقائع ما فيها سعة بحسب واقعها, وما يصدر فيها من روايات
مشتملة على التحديد فليست واردة لبيان الحكم الواقعي بحدِّه.
والقرينة على هذا المعنى أخبارٌ أخرى ذُكر فيها أنّ الصلاة من الموسّعات مّما يدلّ على إرادة هذا المعنى بالأشياء الموسّعة في معتبرة عبد الأعلى بن أعين:
منها: معتبرة زرارة وقد رواها الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر g يقول: (إنّ من الأمور أموراً مضيّقة وأموراً موسّعة، وأنّ الوقت وقتان، الصلاة ممّا فيه السعة فربّما عجّل رسول الله e وربّما أخّر إلَّا صلاة الجمعة، فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام)(١٩) .
ومنها: خبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قال: (إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة, فالصلاة ممّا وُسّع فيه تقدَّم مرة وتؤخّر أُخرى. والجمعة ممّا ضيّق فيها, فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها)(٢٠) .
والذي يظهر كما أُفيد (٢١) أنّ علياً بن حنظلة قد ذكر للإمام g شقوقاً لا يختلف الحكم الإلزامي من جهتها, بل يختلف الحكم غير الإلزامي بلحاظها, وكان يتصوّر أنّ هذا ممّا يجري في سائر الموارد, فنبّهه الإمام g على أنّ الأحكام على قسمين: منها ما لا يكون إلّا على وجه واحد. ومنها ما يكون على وجوه متعدّدة لكونها من الموسّعات.
ومنها: موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله g قال: قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين في قوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: (كلّ ذلك واسع) (٢٢) .
ومنها: معتبرة علي بن رئاب المروية في قرب الإسناد قال سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبد الله g يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منّا، فيقوم بعضنا يصلي الظهر, وبعضنا يصلي العصر وذلك كله في وقت الظهر قال: (لا بأس الأمر واسع بحمد الله ونعمته)(٢٣) .
الأخبار الخاصّة
وهي الأخبار الواردة في مسائل بخصوصها, ويكون وجه الجمع بينها هو حملها على كون الحكم موسّعاً بدلالة بعض أخبار الباب نفسها, فهي كما لاحظنا وردت في موارد خمسة:
١. أوقات الصلوات اليومية.
٢. أعداد الصلوات النوافل.
٣. الصلاة في الحرمين الشريفين.
٤. كيفية الإحرام لحج التمتع من الميقات.
٥. إدراك حدّ المتعة.
المورد الأوّل
اختلاف الأخبار في أوقات الصلوات اليومية
لا شكّ في أنّ أوقات الصلوات اليومية من جملة الأمور الموسّعة عدا صلاة الجمعة التي حدّد وقتها بأوّل الزوال. فوقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس, ووقت الظهرين من الزوال إلى الغروب, ووقت العشاءين من الغروب إلى منتصف اللّيل، على تفصيل مذكور في محلّه.
ولا شكّ أيضاً في اختلاف وقت الفضيلة فيها عن وقت الإجزاء لتواتر النصوص بذلك. ولكن اختلفت النصوص في ما حثّت عليه اختلافاً شديداً, كما اختلف عمل الشيعة في عصر الأئمة i, وقد وقع ذلك في مواضع عديدة نقتصر هنا على التعرض لوقت فضيلة الظهرين.
فقد اختلفت فيه الروايات وعمل الأصحاب منذ عصر الصادق g اختلافاً بيّناً، فقد ورد في بعضها الحثّ على المبادرة إليهما دون انتظار كما رواه منصور بن حازم والحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة, وقد رواه عنهم ابن مسكان، حيث قالوا: كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله g: (ألا أنبئكم بأبيّن من هذا؟ إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظّهر)(٢٤).
وجه الدلالة: إنّ هؤلاء الرواة إنّما كانوا يقيسون الوقت بالذراع طلباً لوقت الفضيلة وليس لوقت الإجزاء, إذ كانت الشّمس قد زالت، ولا شكّ بدخول الوقت بزوالها، وقد وجّههم الإمام g إلى الصّلاة عند الزّوال بعد النّافلة.
ومنها: ما ورد في تحديد وقته بالأقدام, وهذه الطائفة مختلفة، فقد دلّ بعضها على أنّ وقت الظهر من زوال الشّمس ووقت العصر عندما يبلغ الظل أربعة أقدام.
فعن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى g متى يدخل وقت الظهر؟ قال: (إذا زالت الشّمس) فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: (من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام. إنّ وقت الظهر ضيّق) . فقلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: (إنّ آخر وقت الظهر أوَّلُ وقت العصر ...)(٢٥) الحديث.
ومنها: ما دلّ على تحديد وقت الظهرين بالذّراع والذّراعين، كما رواه زرارة، قال زرارة قال لي أبو جعفرg حين سألته عن ذلك إنّ حائط مسجد رسول الله e كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظّهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر...)(٢٦) ، وفي ذيلها (قال ابن مسكان: وحدّثني بالذّراع والذّراعين سليمان بن خالد, وأبو بصير المرادي, وحسين صاحب القلانس, وابن أبي يعفور, ومن لا أحصيه منهم) .
ومنها: ما دلّ على تحديد وقت الظهرين بالقامة والقامتين. فعن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن g قال سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظّل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين)(٢٧).
فالملحوظ اختلاف روايات الباب الواردة عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن موسى g اختلافاً ظاهراً.
وقد وصف هذا الاختلاف بعض الرواة المتأخّرين للأئمة اللاحقين كما في رواية محمّد بن أحمد بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن g روي عن آبائك القدم والقدمين والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين، فكتبg: (لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصلاتين, وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فإنْ شئت طوّلت وإنْ شئت قصرّت، ثُمَّ صلّ صلاة الظّهر, فإذا فرغت كان بين الظّهر والعصر سبحة, وهي ثمان ركعات إنْ شئت طوّلت وإنْ شئت قصرّت ثُمَّ صلّ العصر) .
ولنوضّح حال هذه الرواية سنداً و دلالةً.
أمّا سند الرواية فقد ذكره الشيخ في التهذيب هكذا: (سعد بن عبد الله, عن محمّد ابن أحمد) وطريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله هو: الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ـ أيّ الشيخ المفيد S ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه, عن أبيه, عن سعد بن عبد الله.
أمّا الشيخ المفيد S فقد ترضّى عنه النجاشي O وقال: فضله أشهر من أنْ يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم(٢٨). وقال الشيخ انتهت إليه رئاسة الإمامية (٢٩). وهو من الطبقة الحادية عشر.
وأمّا جعفر بن محمّد بن قولويه فهو صاحب كتاب كامل الزيارات قال النجاشي O:
أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلّائهم في الحديث والفقه(٣٠). وهو من الطبقة العاشرة.
وأمّا محمّد بن جعفر بن قولويه فهو والد صاحب كتاب كامل الزيارات, قال فيه النجاشي: أنّه من خيار أصحاب سعد (٣١) .
ولكن هل يعدّ هذا توثيق؟ يمكن أنْ يُتأمّل فيه. نعم, من يلتزم بوثاقة مشايخ ابن قولويه ـ صاحب كتاب كامل الزيارات ـ كالسيد الخوئي S فهو يُعدّ عنده ثقة، لأنّ ابن قولويه قد أكثر الرواية عن أبيه, فهو ـ أيّ الأب ـ يُعدّ من مشايخ ابن قولويه صاحب الكتاب.
وعليه فيمكن الكلام في هذا الطريق, ولكن الذي يهوّن الأمر وجود طريق آخر للشيخ الطوسي S, وهو: الشيخ المفيد، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد.
أمّا الشيخ المفيد فقد تقدّم ذكر وثاقته.
وأمّا أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين فهو الصّدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، قال عنه النجاشي O: (شيخنا وفقيهنا, ووجه الطائفة بخراسان)(٣٢). وهو من الطبقة العاشرة.
وأمّا الأب فهو علي بن الحسين بن بابويه، قال عنه النجاشي: (شيخ القميين في عصره ومتقدّمهم وفقيههم وثقتهم)(٣٣). وهو من الطبقة التاسعة. وعليه يكون طريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله صحيحاً, ولا إشكال فيه.
وأمّا سعد بن عبدالله فقد قال عنه النجاشي O: (شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها)(٣٤). وهو من الطبقة الثامنة.
وأمَّا محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري فقد قال عنه النجاشي: (كان ثقة في الحديث, إلاَّ أنّ أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل)(٣٥). ولكن هذا لا يضر بوثاقته.
وعليه فلا إشكال في الرواية من جهة ما تقدَّم. ولكن محمّد بن أحمد بن يحيى روى هذه الرواية عن بعض أصحابنا ولم يحدّده, فهو مرسل بإبهام الواسطة، إلاّ أنْ يظهر من النقل وقوفه على الكتاب, لأنَّه قال: (كتب بعض أصحابنا...). هذا عن إسناد الرواية.
وأمَّا الكلام في دلالة الرواية، فالرواية تدلُّ على وجود اختلاف في وقت صلاتي الظّهر والعصر، حيث نُلاحظ أنَّ الوارد عن أهل البيت i مختلف، فالقدم والقدمين يختلف عن القامة والقامتين وهو يختلف عن الذراع والذراعين، وهذا يكشف بصورة واضحة عن أنّ الحكم الوارد في أوقات الصلاة ـ صلاتي الظّهر والعصر ـ لم يكن لبيان الحكم الواقعي بحدّه ـ وإلّا لما كان مختلفاً بهذه الكيفية ـ بل الأمر موسَّع على المكلَّف.
هذا وصف اختلاف الروايات والرواة في فضيلة الوقت.
وقد اختلف الفقهاء في وجه الجمع بين هذه الروايات:
فقد سلك جمع من القدماء مسلك الجمع الدلالي, وهو الّذي رواه الكليني عن علي ابن إبراهيم, عن أبيه, عن صالح بن سعيد, عن يونس, عن بعض رجاله, عن أبي عبد الله g قال: سألته عمَّا جاء في الحديث أنْ صلِّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين, وذراعاً وذراعين, وقدماً وقدمين, من هذا ومن هذا فمتى هذا؟ وكيف هذا وقد يكون الظّل في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: (إنَّما قال ظلّ القامة ولم يقل قامة الظلّ، وذلك أنَّ ظلِّ القامة يختلف: مرّة يكثر، ومرَّة يقلّ، والقامة قامة أبداً لا تختلف).
ثُمَّ قال: (ذراع وذراعان، وقدم وقدمان، فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلُّ القامتين ذراعين، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كلّ زمان معروفين مفسّراً أحدهما بالآخر مسدداً به. فإذاً كان الزمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّ القامة وكانت القامة ذراعاً من الظلّ، وإذا كان ظلّ القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين)(٣٦).
هذا, ولكنّ الأقرب اختلاف مؤدّى هذه الروايات فعلاً كما فهم الأصحاب أنفسهم في تلك العصور، ولكنّ السرَّ في الاختلاف كون الأمر من الموسّعات, وقد أوقع الإمام g الاختلاف بينهم لحكمة.
والذي ينبَّه على هذا ـ مضافاً إلى الرواية العامّة المتقدّمة, وما ذكرناه معها ممّا تضمّن أنَّ وقت الصلاة من الموسّعات, وأنَّ الإمام g يجيب فيها على وجوه ـ روايات ثلاثة:
الرواية الأُولى: ما رواه الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن محمّد، عن أبي الحسن الهادي g, قال كتبتُ إليه: جُعلتُ فداك، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله h أنَّهما قالا: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين, إلّا أنَّ بين يديهما سبحة, إنْ شئت طوّلت وإنْ شئت قصَّرت. وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظّهر على أربعة أقدام من الزوال فإذا صلَّيت قبل ذلك لم يجزك وبعضهم يقول يجزي، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام، وقد أحببت ـ جعلت فداك ـ أن أعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب: (القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً)(٣٧).
أمّا سند الرواية فإنّ طريق الشيخ في المشيخة إلى الحسين بن سعيد معتبرٌ لا إشكال فيه. وأمّا عبد الله بن محمّد فهو الحُضيني, قال النجاشي: (ثقة ثقة)(٣٨). وهو من الطبقة السادسة.
وعليه فالرواية معتبرة.
وأمّا دلالة الرواية فهي تدلّ بصورة واضحة على أنَّ الإمام g لم يكن بصدد بيان الحكم الواقعي بحدّه وإلّا لكان اقتصر على وقت واحد, وهذا يدلّ على أنَّ الوقت من الموسّعات، أي يكون الحكم موسّعاً على المكلَّف.
الرواية الثانية: معتبرة سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله g قال: سأله إنسان وأنا حاضر، فقال: دخلتُ المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلُّون الظهر فقال: (أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذ برقابهم) (٣٩) .
والكلام تارة في سند هذا الحديث. وأخرى في دلالته.
أمَّا سند الحديث فقد رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله g.
أمّا الكليني فهو موثّق صريحاً دون خلاف. قال عنه النجاشي: (أوثق الناس في الحديث وأثبتهم)(٤٠). وهو من الطبقة التاسعة.
أمّا محمّد بن يحيى فهو العطّار من مشايخ الشيخ الكلينيO, قال النجاشي O: (شيخ أصحابنا في زمانه ثقة، عين، كثير الحديث) (٤١) . وهو من الطبقة الثامنة.
وأمّا محمّد بن الحسين فهو ابن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الهمداني، قال عنه النجاشي O: (جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف مسكون إلى روايته)(٤٢). وهو من الطبقة السابعة.
وأمَّا عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي فقال النجاشي O: (أبو محمّد، جليل من أصحابنا ثقة ثقة)(٤٣). وهو من الطبقة السادسة.
وأمَّا سالم أبو خديجة، فهو سالم بن مُكرم بن عبد الله أبو خديجة، قال النجاشي O: (يقال أبو سلمة الكنَّاسي، يقال صاحب الغنم مولى بني أسد الجمَّال، يقال كنيته كانت أبا خديجة وأنَّ أبا عبد الله g كنَّاه أبا سلمة ثقة ثقة)(٤٤).
قد يقال: بأنَّ الشيخ الطوسي S حيث ذكر في الفهرست (٤٥) سالم بن مكرم يكنَّى أبا خديجة، ومُكرم يكنَّى أبا سلمة ضعيف. ومن القريب جداً أنَّ منشأ تضعيف الشيخ لأبي خديجة هو كونه من أصحاب أبي الخطَّاب قبل مقتله (٤٦) .
فيقال: هذا لا يصلح وجهاً للخدش في وثاقة الرجل؛ فإنَّ الرجل بقي بعد ذلك التأريخ مدّة غير قصيرة كان فيها من أصحاب الإمام الصادق g, ثمَّ من أصحاب الإمام الكاظم g وقد روى ابن أبي عمير عنه, وهذا إنَّما يكون بعد الإمام الصادق g ممّا يكشف عن صلاح حاله. وكذلك شهادة علي بن الحسن بن فضّال له بالصلاح التي وردت في كتاب اختيار معرفة الرجال (٤٧) تكشف عن صحة ما ورد في ذيل خبر الكشّي من أنَّه تاب بعد ذلك.
ولعل في تأكيد النجاشي O على توثيقه مرتين إشارة إلى الردّ على ما ذكره الشيخ في الفهرست من تضعيفه, إذ إنَّ النجاشي كان ناظراً إلى فهرست الشيخ.
وعليه فالصحيح ثبوت وثاقته. وهو من الطبقة الخامسة.
والنتيجة: أنَّ الرواية معتبرة ولا إشكال فيها من جهة السند.
وأمَّا دلالة المعتبرة فالإمام g ذكر أنَّه أمرهم بهذا, ولو صلّوا في وقت واحد عُرِفوا فأُخذ برقابهم، وهذا ما أشرنا إليه في الدواعي للأحكام الموسَّعة, وهو أنْ يلقي الإمام g الخلاف بين الشيعة ليعطي انطباعاً لدى السلطة الغاشمة أنَّهم ليسوا بجماعة منظّمة موجّهين من قيادة واحدة، بما يدفع الإمام g بذلك عن نفسه وعن شيعته.
وهذا يدلُّ بوضوح على أنَّ الإمام g لم يكن بصدد بيان الحكم الواقعي بحدِّه, وأنَّ وقت صلاة الظّهر أو العصر هو الوقت الواقعي ولا يجوز مخالفته, وإلّا لما كان
للإمام g أنْ يذكر أوقاتاً مختلفة, فهذا ممّا يكشف عن أنَّ أمر الوقت هو من الأحكام الموسّعة, بمعنى أنَّ هناك سعة في التشريع, وما ورد فيه التحديد بوقت معين فهو لم يصدر لأجل بيان الحكم الواقعي بحدِّه.
الرواية الثالثة: ما رواه الكشِّي بقوله: حدَّثني أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم الورَّاق، قال: حدَّثني علي بن محمّد بن يزيد القمِّي، قال: حدَّثني بنان بن محمّد بن عيسى, عن ابن أبي عمير, عن هشام بن سالم, عن محمّد بن أبي عمير (عمر) , قال دخلت على أبي عبد الله g فقال:
(كيف تركتَ زرارة؟) فقلت: تركته لا يصلِّي العصر حتَّى تغيب الشمس. فقال: (فأنت رسولي إليه فقل له فليصلِّ في مواقيت أصحابه فإنّي حرقت(٤٨)). قال: فأبلغته ذلك. فقال: أنا والله أعلم أنَّك لم تكذب عليه, ولكنْ أمرني بشيء فأكره أنْ أدعه(٤٩).
وهذه الرواية تؤكد ما ذكرناه من أنَّ الحكم بذكر الوقت من الأحكام الموسَّعة, ولأجل هذا يذكر الإمام g وقتين لصلاة العصر لأحد أصحابه وهو زرارة O.
المورد الثّاني
من موارد اختلاف الأخبار في الموسّعات ما ورد في أعداد النوافل
فقد اختلفت الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة i في أعداد النوافل اختلافاً شديداً مما أدَّى الى اختلاف عمل الأصحاب في عصر الأئمة i حتَّى استمّر ذلك إلى عهد الإمام الرضا g، ونُبّه في بعض هذه الروايات كمعتبرة عبد الله بن زرارة على أنَّ السرّ في الاختلاف هو كون الأمر من الموسّعات.
فلنذكر اختلاف روايات الباب أوّلاً, ثمّ نذكر تلك المعتبرة.
ويلاحظ أنّ تلك الروايات بعضها صادر في عصر الصادقينh , والآخر ما بعد عصرهما.
أمّا الروايات الواردة عن الإمام أبي جعفر والإمام أبي عبدالله h فهي على ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: ما تضمّنت أنّ أعداد النوافل إحدى وخمسون.
الطائفة الثّانية: ما تضمّنت أنّ أعداد النوافل أربع وأربعون.
والطائفة الثالثة: ما تضمّنت غيرهما.
الطائفة الأولى: وهي عدّة روايات:
الرواية الأولى: ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي عمير, عن ابن أُذينة, عن فضيل بن يسار, عن أبي عبد اللهgقال: (الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة, منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم. الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة)(٥٠).
والسند معتبر لعدم وجود خلل في الطريق:
أمَّا علي بن إبراهيم فهو ثقة كما عن النجاشي (٥١) . وهو من الطبقة الثامنة.
وأمَّا إبراهيم بن هاشم فالصحيح أنَّه ثقة؛ لوجوه ذكرها الأعلام وقرائن اعتمدوا عليها. وهو من الطبقة السابعة.
وأمَّا ابن أبي عمير فقد ذكر العلمان(٥٢) وغيرهما جلالة قدره ووثاقته. وهو من الطبقة السادسة.
وأمَّا ابن أُذينة فهو عمر بن أُذينة وثَّقه الشيخ(٥٣), ومدحه النجاشي(٥٤). وهو من الطبقة الخامسة.
وأمَّا الفضيل بن يسار فقد وثَّقه العلمان(٥٥). وهو من الطبقة الرابعة.
وأمَّا دلالة المعتبرة فهي تصرَّح بكون النوافل أربعاً وثلاثين ركعة.
الرواية الثانية: رواية الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله g قال: سمعته يقول: (صلاة النّهار ست عشرة ركعة: ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب, يا حارث, لا تدعهنّ في سفر ولا حضر. وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصلّيها وهو قاعد, وإنَّما اُصليها وأنا قائم، وكان رسول الله e يصلِّي ثلاث عشرة من الليل)(٥٦).
أمّا السند فقد رواه الكُليني, وقد ذكره بصيغة التعليق على سابقه بقوله (عنه) , والمذكور في الإسناد السابق محمّد بن يحيى ـ أي العطّارـ، عن أحمد بن محمّد ـ أي ابن عيسى ـ، عن علي بن حديد، عن علي بن النّعمان، عن الحارث بن المغيرة النصريّ. فالرواية ضعيفة سنداً من جهة علي بن حديد فقد ضعّفه الشيخ S(٥٧).
وأمَّا دلالة الرواية فهي تشير بوضوح إلى أنّ أعداد النوافل هي أربع وثلاثون ركعة, فيكون مجموع الركعات إحدى وخمسين.
الرواية الثّالثة: ما رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع, عن حنّان، قال: سأل عمر بن حريث أبا عبد الله g وأنا جالس فقال له: أخبرني ـ جُعلتَ فداك ـ عن صلاة رسول الله e فقال له:
(كان النبي e يصلّي ثماني ركعات الزوال, وأربعاً الأولى, وثماني بعدها, وأربعاً العصر, وثلاثاً المغرب, وأربعاً بعد المغرب, والعشاء الآخرة أربعاً, وثمان صلاة الليل وثلاثاً الوتر, وركعتي الفجر, وصلاة الغداة ركعتين). قلت:
جعلت فداك فإنْ كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: (لا، ولكن يعذَّب على ترك السُنَّة)(٥٨).
والرواية معتبرة لعدم وجود خلل في طريقها.
أمَّا محمّد بن يعقوب فهو الكليني فقد تقدّم ذكر وثاقته.
وأمَّا محمّد بن إسماعيل بن بزيع فهو كوفي, وثَّقه العلمان(٥٩). وهو من الطبقة السادسة.
وأمَّا حنَّان فهو حنَّان بن سدير, وثَّقه الشيخ(٦٠). وهو من الطبقة الرابعة الّتي أدركتها السادسة.
وعليه تكون الرواية معتبرة.
وأمَّا دلالة المعتبرة فهي تثبت كون الركعات إحدى وخمسين ركعة, الفرائض سبع عشرة, والنوافل أربع وثلاثون ركعة.
الرواية الرابعة: ما رواه الشيخ, بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله g قال: (صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس, وأربع ركعات بعد المغرب, وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً، والقيام أفضل ولا تعدّهما من الخمسين, وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بـقل هو الله أحد، وقل يا أيُّها الكافرون في الركعتين الأوليتين, وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن, ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيهما جميعاً (قل هو الله أحد) وتفصل بينهما بتسليم, ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الركعة الأولى منهما بـ [قل يا أيُّها الكافرون] وفي الثانية بـ [قل هو الله أحد)(٦١).
أمَّا السند فهو معتبر؛ لكون طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيحاً ولا إشكال فيه.
وأمَّا الحسين بن سعيد فقد وثَّقه الشيخ الطوسي S(٦٢). وهو من صغار الطبقة السادسة.
وأمَّا عثمان بن عيسى فقد وصفه الشيخ(٦٣) بالوثاقة. هذا, مضافاً إلى إمكان توثيقه لكونه من مشايخ صفوان وابن أبي عمير كما في القبسات(٦٤). وهو من الطبقة الخامسة التي أدركتها السابعة.
وأمَّا ابن مسكان فهو عبد الله بن مسكان, وقد وثَّقه العلمان (٦٥) . وهو من الطبقة الخامسة.
وأمَّا سليمان بن خالد فقد وصفه النجاشي(٦٦) بالوجاهة, وهو دالّ على الوثاقة. وهو من الطبقة الرابعة.
وعليه فالرواية معتبرة سنداً.
وأمَّا دلالة المعتبرة فهي تصرّح بكون النوافل أربعاً وثلاثين ركعة فتكون من روايات الإحدى وخمسين ركعة.
هذه هي الطائفة الأولى من الروايات والتي تضمَّنت الإحدى والخمسين ركعة.
الطائفة الثانية: وهي ما تضمَّنت الأربع والأربعين ركعة, والتي وردت عن الصادقين h, وهي ثلاث روايات:
الرواية الأولى: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله g يقول: (لا تصلِّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة) ، وقال: ورأيته يصلِّي بعد العتمة أربع ركعات(٦٧).
قال الشيخ S بعد كلام له حول الرواية: (ولا يمتنع أنْ يحثّ g على هذه الأربع والأربعين ركعة؛ لتأكّدها وشدّة استحبابها بهذا الخبر ويحثّ على ما عداها بحديث آخر) .
أمَّا سند الحديث فطريق الشيخ S إلى أحمد بن محمّد بن عيسى صحيح لا إشكال فيه.
وأمَّا أحمد بن محمّد بن عيسى فقد وثَّقه العلمان(٦٨). وهو من الطبقة السابعة.
وأمَّا الحسن بن علي بن بنت إلياس فهو الحسن بن علي بن زياد الوشَّاء. وهو من وجوه الطائفة كما عن النجاشي(٦٩). وهو من الطبقة السادسة.
وأمَّا عبد الله بن سنان فقد نصَّ النجاشي(٧٠) على جلالته وعظّم محلَّه في الطائفة. وهو من الخامسة. وعليه تكون الرواية معتبرة السند.
وأمَّا دلالة المعتبرة فهي تشير بوضوح إلى أنَّ الأربع والأربعين ركعة كانت موضع اهتمام الأئمّة i, ولذلك حثّوا على أنْ لا تكون الركعات أقلّ من أربع وأربعين ركعة.
الرواية الثانية: ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله g ما جرت به السُنّة في الصلاة؟ فقال: (ثمان ركعات الزوال، وركعتان بعد الظهر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ومنها الوتر, وركعتا الفجر) قلت: فهذا جميع ما جرت به السُنّة؟ قال: (نعم) . فقال أبو الخطَّاب: أفرأيتَ أنْ قَوِي فزاد قال: فجلس وكان متَّكئاً فقال: (إنْ قويت فصّلها كما كانت تُصلّى, وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل إن الله a يقول: [وَمِنْ آَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ)(٧١).
أمَّا الكلام في السند فقد مرَّ أنَّ طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح، كما مرَّ توثيق الحسين بن سعيد وهو من صغار السادسة.
وأمَّا صفوان فهو ابن يحيى بيَّاع السابري كوفّي ثقة ثقة. وهو من الطبقة السادسة.
وأمَّا ابن بكير فهو عبد الله بن بكير كوفُّي، فقيه فطحيّ، ثقة كما ذكره الشيخ(٧٢). وهو من كبار الخامسة.
وأمَّا زرارة فهو بن أعين كوفي مدحه النجاشي كثيراً(٧٣). وهو من الطبقة الرابعة.
وعليه فالسند معتبر لعدم وجود خلل في الطريق.
وأمَّا الدلالة فإنّ عدد ركعات النوافل المذكورة فيها بعد جمعها يكون المجموع (٢٧) ركعةً, ومع ضمّ الفرائض يكون العدد أربعاً وأربعين, فتكون من الروايات
المتضمّنة للأربع والأربعين ركعة.
الرواية الثّالثة: ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله :g إنِّي رجل تاجر, اختلف واتَّجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال, وكم تُصلَّى؟ قال: (تُصلَّى ثماني ركعات إذا زالت الشمس وركعتين بعد الظهر, وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة، ويصلي بعد المغرب ركعتين، وبعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنَّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض, إنَّ تارك الفريضة كافر, وإنَّ تارك هذا ليس بكافر, ولكنَّها معصية؛ لأنَّه يستحب إذا عمل الرجل عملاً من الخير أنْ يدوم عليه)(٧٤).
أمَّا السند فطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد فقد قلنا بأنَّه صحيح، وكذلك مَرّ توثيق الحسين بن سعيد وأبن أبي عمير، وعمر بن أذينة وزرارة.
فالرواية صحيحة السند.
وأمَّا الدلالة فقد ذكرت الرواية أنَّ النوافل سبع وعشرون ركعة, وبضمِّها إلى الفرائض تكون الركعات أربعاً وأربعين ركعة، وعليه فهذه الرواية هي من روايات المتضمّنة للأربع والأربعين ركعة.
الطائفة الثالثة: وهي رواية واحدة وقد رواها الكُليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله gعن أفضل ما جرت به السُنّة من الصلاة؟ فقال: (تمام الخمسين)(٧٥).
والرواية ضعيفة بـمحمّد بن سنان.
والظاهر أنّ محمّد بن أبي عمير هنا ليس هو المشهور الذي هو من أصحاب الرضا g بل هو رجل آخر كان من أصحاب الصادق g كما نبّه على وجوده جماعة, وهو ممّن لم تثبت وثاقته.
وأمّا دلالة الرواية فهي صرَّحت بكون ما جرت به السُنَّة من الصلاة هي تمام الخمسين.
الطائفة الرابعة: ـ ما دلّت على كون العدد ستاً وأربعين ـ وهي رواية واحدة أيضاً وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمَّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله g عن التطوّع بالليل والنهار فقال: (الذي يستحب أنْ لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان, وقبل العُتمة ركعتان, ومن السحر ثمان ركعات ثمَّ يوتَّر والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثُمَّ ركعتان قبل الفجر، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل)(٧٦).
وأمّا الكلام في السند فقد تقدم الكلام في طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد وأنّه صحيح.
وأمَّا حمَّاد بن عيسى فقد وثَّقه العلمان (٧٧). وهو من الخامسة.
وأمَّا شعيب فهو شعيب بن يعقوب العقرقوفي، ثقة، عين كما عن النجاشي(٧٨).
وهو من الطبقة الخامسة.
وأمَّا أبو بصير فهو يحيى بن أبي القاسم الأسدي، وشعيب العقرقوفي هو ابن أخت يحيى بن أبي القاسم، وهو ثقة وجيه كما عن النجاشي(٧٩). وهو من الطبقة الرابعة.
وعليه فالرواية معتبرة لعدم وجود خلل في سندها.
وأمَّا دلالة الرواية فإنّها من روايات الطائفة الثّالثة؛ إذ تضمَّنت صلاة ستّ وأربعين ركعة.
هذه هي الطوائف التي وردت في عصر الإمامين الصادقين h.
وأمَّا الروايات التي وردت بعد عصر الصادقين h فهي أيضاً على طوائف متعدّدة, ممّا يُبيّن أنّ الأئمة اللاحقين اهتمّوا ببقاء هذا الخلاف.
الطائفة الأولى: وهي عدّة روايات:
الرواية الأولى: ما رواه محمّد بن الحسن، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن:g إنَّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوَّع بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتَّى أعمل بمثله؟ فقال: (أُصلّي واحدة وخمسين ثُمَّ قال أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية وأربعاً بعد الظهر، وأربعاً قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تُعدان بركعة من قيام، وثماني صلاة الليل، والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون)(٨٠).
أمَّا سند الحديث فهو ضعيف بسهل بن زياد الآدمي حيث ضعّفه ابن الغضائري(٨١) وكذلك النجاشي(٨٢), والشيخ في الفهرست(٨٣).
وأمَّا دلالة الرواية فهي تذكر أنَّ أصحاب أهل البيت i يختلفون في ذكر أعداد الصلوات فبعضهم يذكر أنَّها أربع وأربعون، والبعض الآخر يذكر أنَّها خمسون ممّا يدلّ على التوسعة في أعداد النوافل؛ لأنَّ الفرائض ثابتة ولا تغيَّر فيها.
الرواية الثّانية: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن, قال: حدَّثني إسماعيل بن سعد الأحوص القمِّي, قال: قلت للرضاgكم الصلاة من ركعة؟ قال: (إحدى(٨٤) وخمسون ركعة)(٨٥).
أمَّا سند الرواية فإنَّ طريق الشيخ إلى محمّد بن أحمد بن يحيى صحيحُ لا خلل فيه.
وأمَّا محمّد بن أحمد بن يحيى، فقد ذكر النجاشي وثاقته(٨٦)، وذكر الشيخ جلالة قدره(٨٧). وهو من صغار الطبقة السابعة.
وأمَّا محمّد بن عيسى اليقطيني، فقد وثَّقه النجاشي(٨٨). وهو من كبار السابعة.
وأمَّا يونس بن عبد الرحمن فهو عظيم المنزلة كما عن النجاشي(٨٩), ووثَّقه الشيخ أيضاً(٩٠). وهو من كبار السادسة.
وأمَّا إسماعيل بن سعد الأحوص فهو قمي وثَّقه الشيخ(٩١). وهو من السادسة. وعليه تكون الرواية معتبرة السند.
وأمَّا الدلالة فالرواية تصرَّح بكون الركعات التي ينبغي أنْ يأتي بها المكلَّف هي إحدى وخمسون ركعة.
الطائفة الثّانية: ما دلّت على أنّها ست وأربعون ركعة, وهي رواية واحدة رواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن حبيب قال: سألت الرضا g عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة قال: (ست(٩٢) وأربعون ركعة فرائضه ونوافله) .
قلت: هذه رواية زرارة. قال: (أوَ ترى أحداً كان أصدع بالحق منه)(٩٣).
أمّا الكلام في السند فالرواية ضعيفة بيحيى بن حبيب؛ حيث لم يرد في حقَّه توثيق من قبل الشيخ والنجاشي، بل لم يُذكر.
وأمَّا دلالة الرواية فهي تشير بوضوح إلى أنَّ الصلوات هي ست وأربعون ركعة، وهذا يعني أنَّ أعداد النوافل هي تسع وعشرون بينما لو كانت الركعات إحدى وخمسين لكانت أعداد النوافل أربعاً وثلاثين ركعة.
الطائفة الثّالثة: ما دلّت على أنّها خمسون ركعة, وهي رواية واحدة أيضاً رواها الشيخ بإسناده عن سعد، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا g: (أنَّ أبا الحسنg كان إذا اغتم ترك الخمسين)(٩٤).
قال الشيخ S: (قوله g: ترك الخمسين. يريد به تمام الخمسين؛ لأنَّ الفرائض لا يجوز تركها على كل حال).
أمَّا سند الحديث فسعد المذكور في الرواية هو سعد بن عبد الله الأشعري، وطريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله في المشيخة صحيح لا إشكال فيه.
وأمَّا سعد بن عبد الله فهو شيخ هذه الطائفة وفقيهها وجيهها كما عن النجاشي(٩٥). وهو من الطبقة الثامنة.
وأمَّا معاوية بن حكيم فهو كوفي ثقة جليل، كما عن النجاشي(٩٦). وهو من الطبقة السابعة.
وأمَّا معمّر بن خلّاد فهو بغدادي ثقة، كما عن النجاشي(٩٧). وهو من الطبقة السادسة.
وعليه تكون الرواية معتبرة السند.
وأمَّا دلالة المعتبرة فهي تدلّ بوضوح على أنَّ الركعات التي ينبغي أنْ يأتي بها المكلَّف هي خمسون ركعة، ولذلك قال الشيخ S المراد من ترك الخمسين هو ترك تمام
الخمسين, وهذا يكشف عن أنَّ الصلوات هي خمسون ركعة.
هذه هي مجموعة الروايات الواردة في أعداد النوافل سواء في عصر الصادقين h أم بعده, وهي كما ترى مختلفة في العدد.
وأمَّا الرواية التي نبَّهت على أنَّ الاختلاف في أعداد النوافل إنَّما هو من جهة التوسعة فهي معتبرة عبد الله بن زرارة، وهي ما رواه الكشي بقوله: حدثني حمدويه بن نصير، قال: حدثنا محمّد بن عيسى بن عبيد قال: حدثني يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زرارة. ومحمد بن قولويه والحسين بن الحسن، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قال حدثني هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة قال: (...وعليك بالصلاة الست والأربعين، وعليك بالحج أنْ تستهل بالإفراد, وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة). ثم قال: (والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والإهلال بالتمتع إلى الحج، وما أُمرنا به من أنْ يهلّ بالتمتع فلذلك عندنا معانٍ وتصاريف, لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء من الحق ولا يضادّه)(٩٨).
ومحلّ الشاهد من الرواية ما جاء في الصلاة, ولا شاهد لنا هنا فيما ذُكر في أمر الحجّ.
والكلام في هذه الرواية يقع تارة في السند. وأُخرى في الدلالة.
أمَّا السند فالرواية معتبرة كما عبّرنا، وذلك لأنّ للرواية طريقين:
أمَّا الطريق الأوّل فهو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي هو صاحب كتاب الرجال قال عنه النجاشي: (الكشّي أبو عمرو، ثقة، عين)(٩٩). وقال الشيخ الطوسي S: (محمّد ابن عمر بن عبد العزيز الكشي, يكنَّى أبو عمرو ثقة بصير بالأخبار وبالرجال, وحسن الاعتقاد)(١٠٠). وهو من صغار التاسعة.
وأمَّا حمدويه بن نصير فقال الشيخ الطوسي Sعنه: (عديم النظير في زمانه, كثير العلم والرواية, ثقة, حسن المذهب)(١٠١). وهو من الثامنة.
وأمَّا محمّد بن عيسى بن عبيد فقد قال النجاشي O عنه: (ابن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة أبو جعفر من أصحابنا ثقة، عين)(١٠٢). وهو من كبار السابعة.
وأمَّا يونس بن عبد الرحمن فقد تقدّم ذكر وثاقته. وعليه تكون الرواية معتبرة.
ولو نُوقش في اعتبارها من جهة حمدويه بن نصير، إذ إنَّه لم يرد ذكره في رجال النجاشي, ولا في فهرست الشيخ.
فيمكن تصحيح اعتبارها بوجود طريق ثانٍ معتبر للرواية, ومع تعدّد الطريق للرواية يمكن الاطمئنان بصدور الرواية عن المعصوم g على مبنى حجيّة الخبر الموثوق به دون مبنى حجيّة رواية الثقة.
وأمّا الطريق الثّاني فإنّ محمّد بن قولويه هو والد صاحب كتاب كامل الزيارات, قال عنه النجاشي (١٠٣) إنّه كان من خيار أصحاب سعد بن عبد الله. وهو من التاسعة .
وأمّا الحسين بن الحسن بن بندار فهو لم يوثّق. وليس هو الحسين بن الحسن بن برد الدينوري لكونه ـ أيّ الدينوري ـ من الطبقة السادسة, بينما بن بندار من الطبقة التاسعة؛ لكونه في طبقة محمّد بن قولويه. ولكن لا يضرّ عدم ثبوت وثاقته بعد أنْ كان ابن قولويه ثقة .
وأمّا سعد بن عبد الله فقد تقدّم ذكر وثاقته وهو من الثامنة .
وأمّا هارون بن الحسن بن محبوب فهو ثقة صدوق كما ذكره النجاشي(١٠٤). وهو من السابعة .
وأمّا محمّد بن عبد الله بن زرارة فقد ذكر النجاشي: أنّ محمّد بن الحسن بن الجهم كان يقول: (وكان والله محمّد بن عبد الله ـ أيّ ابن زرارة ـ أصدق عندي لهجة من أحمد بن الحسن ـ أيّ ابن فضّال ـ فإنَّه رجل فاضل ديّن)(١٠٥). ومن الواضح أنّ هذا لا يفيد التوثيق.
وأمّا الحسن والحسين ابنا محمّد بن عبد الله بن زرارة فلم يرد ذكرهما, فهما مجهولان.
وأمّا عبد الله بن زرارة فقد تقدّم ذكر وثاقته .
والحاصل: إنّ هذا الطريق الآخر ليس بمعتبر. ولكن وجود طريقين مع اختلاف طبقة الضعيف في كل من الطريقين يوجب الاطمئنان ـ على مبنى حجيّة الرواية الموثوق بها لا على مبنى رواية الثقة خاصّة ـ بصدور الرواية عن المعصوم gلاستبعاد تواطؤهم على الكذب بعد اختلاف طبقة كلٍّ منهما. وعليه فالرواية معتبرة.
وأمّا الكلام في الدلالة فإنّ الإمام g صرّح بأنّ ما قاله لأبي بصير غير ما قاله لزرارة، فالإمام g يقول لزرارة عليك بالست والأربعين, فيكون مجموع النوافل تسعاً وعشرين ركعة، بينما يقول لأبي بصير أنّ الصلاة إحدى وخمسون, فيكون مجموع النوافل أربعاً وثلاثين ركعة, فيكون أعداد النوافل مختلفة، ثُمَّ يقول الإمام g بعد ذلك (ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يُضادّه) , وهذا القول شديد الوضوح بأنّ كُلاً من الأمرين حقّ، ولكن ربّما لا يكون الحقّ بحدّه؛ فإنَّه إذا كان مجموع ركعات الصلوات المأمور بها إحدى وخمسين، يكون الأقلّ من ذلك حقّاً أيضاً, ولكن ليس كل الحقّ بل بعضه،
فإذا اقتصر المكلّف على الست والأربعين, فإنّه يكون قد أتى بما أمر به الإمام g ويكون محصّلاً للثواب .
وكيف كان: فإنّ هذه الرواية واضحة الدلالة على أنّ أعداد النوافل فيها سعة في التشريع, وأنّه يمكن الإتيان بالأقلّ ـ أيّ الست والأربعين ـ دون الواحد والخمسين, ويكون قد أتى ما أُمر به، لا أنّه لو أتى بالأقلّ لم يكن محصّلاً ومصيباً للثواب .
لا يقال: إنّ النوافل الرواتب مستحبة في نفسها, فيمكن الاقتصار على بعضها من دون أنّ تعدّ من الأحكام الموسّعة .
فإنّه يقال: إنَّ عدّ النوافل الرواتب من الأحكام الموسّعة يكشف على أنّ البعض الذي يجوز الاقتصار عليه يكون وارداً عن أهل بيت العصمة i.
المورد الثّالث
من موارد اختلاف الأخبار في الموسّعات
ما ورد في الصلاة في الحرمين الشريفين مكة والمدينة
اختلفت الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة عليه السلام, إذ الصلاة في الحرمين الشريفين ورد في بعضها القصر, وفي بعضها التمام, ممّا أدّى إلى اختلاف عمل الشيعة في ذلك في طبقة أصحاب أبي عبد الله g ومن بعدهم, وقد جاء في معتبرة معاوية بن وهب ـ الآتية ـ حيث أمره الإمام g بالقصر: فقلت: إنّ أصحابنا رووا عنك إنّك أمرتهم بالتمام؟ فقال: (أنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون, والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام) .
وهو يدلّ على قصر جماعة من الأصحاب من الطبقة الرابعة والخامسة. كما جاء في رواية سعد بن عبد الله ـ الآتية في محلها ـ (سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد: مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين g والذي روي فيها؟ فقال: أنا أقصر, وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون ) , فهذه الرواية تدلّ على أّن البغداديّين والكوفيّين من الطبقة السادسة كانوا يقصرون الصلاة, ومن الطبيعي أنّ جماعة آخرين من أصحابنا كانوا يتمّون في تلك الطبقة عملاً بأمرهم بالإتمام, ممّا يُنبّه على أنّ الصلاة في الحرمين الشريفين من الأحكام الموسّعة.
وقد أشارت أكثر من رواية إلى هذا المعنى كمعتبرة علي بن يقطين, والحسين بن المختار كما سنبيّن ذلك في آخر المورد.
وقبل ذلك نستعرض الروايات الواردة في عصر الصادقين hأوّلاً, ثُمَّ الروايات الواردة ما بعد عصرهما h.
أمّا الروايات الواردة في عصر الصادقين h فهي على طائفتين.
الطائفة الأولى: ما ورد في الإتمام.
الطائفة الثانية: ما ورد في القصر .
أما الطائفة الأولى فهي عدّة روايات:
الرواية الأولى: ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب, عن صفوان, عن مسمع, عن أبي عبد الله g قال: قال لي: (إذا دخلت مكة فأتمّ يوم تدخل)(١٠٦).
والكلام أوّلاً في سندها ..
أمّا طريق الشيخ إلى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب فهو مجهول, إذ لا طريق له إلى الرجل في المشيخة, وأمّا تصحيح الحديث بإسناده إليه في الفهرست حيث ذكر ما لفظه: (ابن أبي جيد, عن ابن الوليد عن الصفّار، عنه) فهو محلُّ نظر على تقدير صحّته. بل منع؛ لأنّ إسناد الفهرست ينتهي إلى كتاب الرجل, ولا يُحرز فيمن ابتدأ به في التهذيب أنّه نقله عن كتابه.
نعم, يُرجّح أخذ الرواية بشهادة سياقها عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب ؛ حيث إنّ كتابه أحد مصادر التهذيب.
وأمّا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب فقد مرّ توثيقه. وهو من السابعة .
وأمّا صفوان فهو ابن يحيى كوفي ثقة، كما تقدّم. وهو من السادسة.
وأمّا مسمع فهو بن عبد الملك, وهو ثقة (١٠٧) , من الطبقة الخامسة.
وعليه تكون الرواية معتبرة .
وأمّا الدلالة فالرواية صريحة في كون الصلاة في مكة المكرمة تامّة .
الرواية الثانية: ما رواه الشيخ في التهذيب, عن محمّد بن علي بن محبوب, عن محمّد ابن عبد الجبار, عن صفوان, عن عبد الرحمن بن الحجاج, قال: سألت أبا عبد الله g عن التمام بمكة والمدينة؟ قال: (أتمّ, وإنْ لم تُصلّ فيها إلَّا صلاة واحدة)(١٠٨).
أمّا الكلام في السند فطريق الشيخ إلى محمّد بن علي بن محبوب في المشيخة صحيح لا إشكال فيه.
وأمّا محمّد بن علي بن محبوب فقد قال عنه النجاشي: (شيخ القميين في زمانه, ثقة, فقيه, صحيح المذهب)(١٠٩). وهو من صغار السابعة.
وأمّا محمّد بن عبد الجبار ويُعبّر عنه أيضاً بمحمّد بن أبي الصهبان فهو قميّ ثقة كما عن الشيخ (١١٠). وهو من السابعة.
وأمّا صفوان فقد تقدّم ذكر وثاقته, وهو من السادسة .
وأمّا عبد الرحمن بن الحجّاج فهو كوفي ثقة ثقة, ثَبْتٌ, وجه, كما عن النجاشي(١١١). وهو من الخامسة.
وعليه تكون الرواية معتبرة.
وأمّا دلالة الرواية فهي صريحة في كون الصلاة التي يؤديها الفرد في الحرمين تامّة ولو كانت صلاة واحدة.
الرواية الثّالثة: ما رواه الكُليني عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن إسماعيل ابن مرار, عن يونس, عن معاوية, عن أبي عبد الله g: (إنّ من المذخور الإتمام بين الحرمين)(١١٢).
أمّا سند الحديث ففي اعتبار الرواية بحثٌ من جهة إسماعيل بن مرار؛ إذ لم يرد في حقه توثيق خاصّ. وأمّا وروده في تفسير القميّ فلا يوجب التوثيق له لبحثٍ في هذا التفسير كبرى وصغرى لا يناسب إيراده في المقام.
نعم, ربما يُوثق به من جهة اعتماد القُميّين عليه في رواية كتب يونس بن عند الرحمن من غير طعن, بينما طُعن على الطريق الآخر إليه, وهو طريق محمّد بن عيسى بن عُبيد. وإنْ كان هذا الطريق قد تأمّل فيه السيد الأُستاذ حيث قال: (إنّ الاعتماد على روايات إسماعيل بن مرار لا يخلو عن إشكال)(١١٣).
وأمّا دلالة الرواية فهي تشير بوضوح إلى أنّ الصلاة في الحرمين تامّة من المذخور عن الأئمة i.
وأمّا الطائفة الثانية ـ وهي الواردة في كون الصلاة قصراً ـ فهي رواية واحدة رواها الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم, عن عبد الرحمن, عن معاوية بن وهب, قال: سألت أبا عبد الله g عن التقصير بين الحرمين والتمام؟ فقال: (لا تتمّ حتى تجمع على مقام عشرة أيام) فقلت إنّ أصحابنا رووا عنك إنّك أمرتهم بالتمام، فقال: (إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون, والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام)(١١٤).
والكلام في السند:
أمّا طريق الشيخ إلى موسى بن القاسم في المشيخة فصحيح.
وأمّا موسى بن القاسم فهو كوفي وثّقه العلمان (١١٥). وهو من كبار السابعة.
وأمّا عبد الرحمن فهو ابن أبي نجران بدليل رواية موسى بن القاسم عنه، وثّقه النجاشي(١١٦). وهو من السادسة.
وأمّا معاوية بن وهب فهو ثقة حسن الطريقة كما عن النجاشي(١١٧). وهو من الخامسة.
وعليه تكون الرواية معتبرة السند.
وأمّا الكلام في دلالة المعتبرة فهي تدلّ على أنّ الصلاة في الحرمين هي القصر, كما هو ظاهر قول الإمام g: (لا تتمّ حتى تجمع على مقام عشرة أيام) . نعم, هي من جهة أُخرى تبيّن أنّ الصلاة تامّة جائزة رعايةً لبعض المصالح التي نُبّه عليها في الرواية, وهو أنّ لا يكون هناك تشنيع على الشيعة من خلال الصلاة قصراً, وأنّهم يخالفون الصف.
فالنتيجة أنّ هذه المعتبرة تعدّ من روايات الصلاة قصراً في الحرمين الشريفين.
كما أنّ الرواية تُشير إلى أنّ هذا المورد من الموسّعات بالنظر إلى تصريح الإمام g فيها بأنّه أمر جماعةً من الأصحاب بالتمام؛ كي لا يخرجوا عندما يدخل الناس في المسجد, ولولا جواز التمام لم يكفِ هذا المقدار لأمرهم بالتمام؛ لأنّ الزيادة مبطلة للصلاة, إلّا إذا خاف عليهم ضرراً أو مفسدة.
وأمّا الروايات الواردة فيما بعد عصر الصادقين h فهي كثيرة جداً, وهي أيضاً طائفتان حيث دلّ بعضها على التمام وبعضها الآخر على القصر.
الطائفة الأُولى: ما دلّت على التمام. وهي روايات عدّة:
الرواية الأولى: ما رواه الكُليني, عن عدة من أصحابنا, عن أحمد بن محمّد, عن عثمان بن عيسى, قال سألت أبا الحسن g عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين. فقال: (أتمها ولو صلاة واحدة)(١١٨).
أمّا السند فعدّة الكُليني عن أحمد بن محمّد بن عيسى مذكورة وفيهم الثقة كمحمّد ابن يحيى العطار.
وأمّا أحمد بن محمّد فهو ابن عيسى, وقد مرّت وثاقته سابقاً. وهو من السابعة.
وأمّا عثمان بن عيسى فقد تقدّم توثيقه. وهو من الخامسة التي أدركتها السابعة.
وعليه فالرواية معتبرة السند.
أمّا الدلالة فهي صريحة بكون الصلاة في الحرمين تامّة ولو كانت صلاة واحدة.
الرواية الثّانية: ما رواه الكُليني أيضاً عن العدة, عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً, عن علي بن مهزيار, قال: كتبت إلى أبي جعفرg أنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك i في الإتمام والتقصير في الحرمين, فمنها بأنْ يتمّ الصلاة ولو صلاة واحدة. ومنها أنْ يقصر ما لم ينوِ مقام عشرة أيام. ولم أزل على الإتمام فيها إلى أنْ صدرنا في حجّنا في عامنا هذا, فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير, إذ كنت لا أنوي مقام عشرة أيام قصدت إلى التقصير, وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب إليّ بخطه: (قد علمتَ ـ يرحمك الله ـ فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فإنّي أحب لك إذا دخلتهما أنْ لا تقصر، وتكثر فيهما الصلاة). فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إنّي كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا، فقال: (نعم). فقلت: أيّ شيء تعني بالحرمين. فقال: (مكة والمدينة)(١١٩).
أمّا سند الرواية فهو معتبر كما مرّ آنفاً، كما مرّ أيضاً ذكر وثاقة أحمد بن محمّد بن عيسى.
وأمّا سهل بن زياد فهو ضعيف. ولكن لا يضرّ ضعفه بعد اقترانه بأحمد بن محمّد ابن عيسى.
وأمّا علي بن مهزيار فقد وثّقه العلمان(١٢٠). وهو من كبار السابعة .
وأمّا الدلالة فهي صريحة في التمام عند إيقاعها في الحرمين الشريفين.
الرواية الثّالثة: ما رواه الكُليني عن العدة, عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد, عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر, عن إبراهيم بن شيبة, قال: كتبت إلى أبي جعفر g أساله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إليّ: (كان رسول الله e يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثرْ فيهما وأتمّ)(١٢١).
أمّا سند الحديث فلا إشكال فيه إلّا من جهة إبراهيم بن شيبة, فإنّ فيه بحثاً حيث إنّه لم يرد فيه توثيق. ولكن يمكن أن يُحكم بوثاقته بناءً على وثاقة مشايخ البزنطي وابن أبي عمير وصفوان بن يحيى فتكون الرواية معتبرة من هذه الجهة.
وأمّا الكلام في الدلالة فهي واضحة بالأمر بالتمام عند الصلاة في الحرمين الشريفين.
الرواية الرابعة: ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب, عن صفوان, عن عمر بن رباح, قال: قلت: لأبي الحسن g أقدِمُ مكة أتمّ أو أقصر؟ قال: (أتمّ). قلت: وأمرُّ على المدينة فأتمّ الصلاة أو أقصر؟ قال: (أتمّ)(١٢٢).
أمّا السند إلى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب فقد تقدّم الكلام فيه، وكذلك فيه وفي صفوان.
وأمّا عمر بن رباح فهو وإنْ لم يرد فيه توثيق، لكن يكفي في توثيقه رواية صفوان ابن يحيى عنه, فهو أحد الثلاثة الذين لا يروون لا يرسلون إلَّا عن ثقة, فتكون الرواية معتبرة بهذا التوثيق العامّ.
وأمّا دلالة الرواية فهي صريحة بالأمر بالتمام عند الصلاة في مكة والمدينة.
وأمّا الروايات الواردة عمّن بعد عصرهما h من أهل بيت العصمة قصراً عند إيقاعها في الحرمين فهي روايات عديدة:
الرواية الأولى: معتبرة محمّد بن إسماعيل بن بزيع, وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع, قال: سألت الرضا g عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام؟ فقال: (قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة)(١٢٣).
أمّا السند فقد تقدّم ذكر وثاقة رجاله.
وأمّا الكلام في الدلالة فهي صريحة في أنّ الصلاة في الحرمين الشريفين قصر ما لم يعزم على مقام عشرة أيام .
الرواية الثانية: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن حديد, قال: سألت الرضا g فقلت: إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصّر وبعضهم يتمّ, وأنا ممّن يتمّ على رواية قد رواها أصحابنا في التمام, وذكرتُ عبد الله بن جندب أنّه كان يتمّ. قال: (رحم الله ابن جندب، ثُمَّ قال لي: لا يكون الإتمام إلَّا أنْ تُجمع على إقامة عشرة إيام، وصلِ النوافل ما شئت) . قال ابن حديد: وكان محبتي أنْ يأمرني بالإتمام(١٢٤).
أمّا السند فغير معتبر لوجود علي بن حديد وقد تقدّم تضعيف الشيخ له.
وأمّا الدلالة فإنّ الرواية أشارت إلى أنّ الإمام الرضا g أمر ابن حديد أنْ يصلي قصراً في الحرمين ما لم ينوِ إقامة عشرة أيام, فهي تدل على القصر عند الصلاة في الحرمين الشريفين.
الرواية الثالثة: ما رواه جعفر بن محمّد بن قولويه, عن أبيه, عن سعد بن عبد الله, قال: سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد: مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين g والذي روي فيها؟ فقال: أنا أقصّر وكان صفوان يقصّر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصّرون(١٢٥).
أمّا السند فإنّ ابن قولويه هو صاحب كامل الزيارات, ثقة كما عن النجاشي(١٢٦). وهو من الطبقة العاشرة.
وأمّا محمّد بن قولويه ـ والد صاحب كامل الزيارات ـ وسعد بن عبد الله فقد تقدّم ذكر وثاقتهما.
وأمّا أيوب بن نوح فهو ابن درّاج, وهو كما ذكر النجاشي(١٢٧) عظيم المنزلة عند الإمامين الهادي والعسكري h. وعليه فالرواية تكون تامّة السند.
وأمّا الدلالة فالرواية وإنْ لم ترد عن المعصوم g ولكنها تكشف بصورة واضحة عن أنّ أصحاب أهل البيت i لاسيّما صفوان وابن أبي عمير ـ وهم من أجلّ أصحاب الإمام الرضا ـ كانوا يعملون على ذلك, فيكشف هذا عن أنّ الروايات الواردة عن الإمام الكاظم أو الإمام الرضا h تأمر بالقصر, وإلّا لما عَمِل بالقصر أجلّ أصحابهم.
وأمّا الروايات التي تدلّ بوضوح على أنّ الصلاة في الحرمين الشريفين من الأحكام الموسّعة, وأنّ المكلّف مخيّر بين القصر والتمام فهي روايات ثلاث:
الرواية الأولى: ما رواه الكُليني عن محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد, عن علي بن الحكم, عن الحسين بن المختار, عن أبي إبراهيم g قال: قلت له: إنّا إذا دخلنا مكة والمدينة نُتمّ أو نقصّر قال: (إنْ قصّرت فذاك, وإنْ أتممت فهو خير تزداد)(١٢٨).
أمّا الكلام في السند فقد تقدّم الكلام في الكليني ومحمّد بن يحيى العطار وأحمد بن محمّد بن عيسى.
وأمّا علي بن الحكم فهو ثقة, جليل القدر, كما عن الشيخ (١٢٩) , وهو من السابعة.
وأمّا الحسين بن المختار فهو القلانسي فقد ذكر المفيد O في الإرشاد: أنّ (ممّن روى النصّ على الرضا علي بن موسى h بالإمامة من أبيه والإشارة إليه منه بذلك, من خاصّته وثقاته, وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته: داود بن كثير الرقي، ومحمّد بن إسحاق بن عمار، وعلي بن يقطين، ونعيم القابوسي، والحسين بن المختار، وزياد بن مروان ، والمخزومي، وداود بن سليمان، ونصر بن قابوس، وداود بن زربي، ويزيد بن سليط، ومحمّد بن سنان (١٣٠). وهذا تصريح بكونه من خاصة الإمام الكاظم g وثقاته.
ولو نوقش(١٣١) في وثاقته على أساس أنّ عبارة المفيد في الإرشاد يصعب البناء على أنّها مسوقة لبيان الواقع بالنسبة إلى جميع المذكورين. فيمكن توثيقه من جهة أنّ العلّامة ذكر عن ابن عقدة أنّ ابن فضّال وثّقه(١٣٢), وهو كافٍ في التوثيق. وهو من الخامسة. وعليه تكون الرواية معتبرة السند.
وأمّا الدلالة فالمعتبرة تشير بوضوح إلى أنْ المكلّف إنْ صلّى قصراً فقد أدّى ما عليه من التكليف, كما أنَّ له أنْ يصلّي تماماً فيزداد خيراً, وهذا يكشف عن أنّ الصلاة في الحرمين الشريفين من الأحكام الموسّعة, وأنّ المكلّف في سعة من التشريع بين القصر والتمام.
الرواية الثانية: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن محمّد بن أبي عمير, عن سعد بن أبي خلف, عن علي بن يقطين, عن أبي الحسن g في الصلاة بمكة قال: (منْ شاء أتمّ, ومن شاء قصّر)(١٣٣).
وأمّا السند فقد تقدّم الكلام فيه إلى سعد.
وأمّا سعد بن أبي خلف فقد وثّقه العلمان(١٣٤). وهو من الخامسة.
وأمّا علي بن يقطين فهو ثقة جليل القدر(١٣٥), وهو من الخامسة أيضاً. وعليه فالرواية معتبرة.
وأمّا دلالة المعتبرة فهي تصرّح بأنّ المكلّف مخيّر بين الصلاة تماماً أو قصراً، ممّا يدلّ على أنّ الصلاة في الحرمين الشريفين من الأحكام الموسّعة التي يكون فيها سعة في التشريع, بحيث لا ينحصر بمورد واحد وهو التمام أو القصر بل أيّهما يأتي به يكون ممتثلاً.
الرواية الثالثة: ما رواه الشيخ بإسناده إلى الكُليني عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن إسماعيل بن مرار, عن يونس, عن علي بن قطين, قال: سألت أبا إبراهيم g عن التقصير بمكة فقال: (أتمّ, وليس بواجب, إلَّا أنيّ أحبّ لك مثل الذي أحبّ لنفسي)(١٣٦). وهذه الرواية قد تُعدّ من الروايات الدالة على التوسّعة أيضاً بتصريح فيها بأنّه ليس بواجب.
واعتبار الرواية محلّ كلام لوجود إسماعيل بن مرار, وقد تقدّم الكلام فيه.
وأمّا دلالة الرواية فهي تبيّن أنّ الأئمة كانوا يحثّون على الإتمام في الصلاة عند إيقاعها في الحرمين الشريفين.
والظاهر اتحاد هذه الرواية مع سابقتها؛ لوحدة الراوي المباشر والمروي عنه وتماثل المضمون.
والحاصل من هذا المورد: إنّ اختلاف الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة i وكذلك عمل الأصحاب يدلّ بوضوح على أنّ هذا الباب ـ الصلاة في الحرمين ـ من الأحكام الموسّعة التي يكون التشريع فيها موسّعاً, بحيث يمكن للمكلّف أنْ يأخذ بأيّ منها, ولم يكن صدور البعض منها لأجل بيان الحكم الواقعي حتى يكون الأخذ بخلافها منهيّاً عنه ومخالفاً للحكم الإلزامي, بل يكون الأخذ بالبعض الآخر مُجزياً ومحصِّلاً للثواب. نعم, قد يكون هناك فضلٌ أكثر عند الإتيان بالصلاة التامّة من باب أنّ أفضل الأمور أحمزها, إلّا أنّ هذا لا يعني أنّ الإتيان بالصلاة قصراً يكون مخالفاً للحكم الواقعي وغير مجزٍ, فيكون اقتصار الإمامg ـ حينئذٍ ـ على القصر في بعض الأحيان لأجل رعاية بعض المصالح التي مرّ ذكرها.
المورد الرابع
من موارد اختلاف الأخبار
ما ورد في كيفيّة الإحرام لحجّ التمتع من الميقات
اختلفت الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت i في كيفية الإحرام لحجّ التمتع ممّا أدّى إلى اختلاف عمل الأصحاب, إذ إنّ بعضها ورد بالتلفظ بالعمرة عند التلبية. وأُخرى بالتلفظ بالحج. وثالثة بالتلفظ بالعمرة والحج جميعاً. ورابعة لم تذكر شيئاً منها. فهنا أربع طوائف من الروايات سوف نذكرها, ثمّ نذكر معتبرة عبد الله بن زرارة التي تدلّ بوضوح على أنّ الإحرام لحجّ التمتع من الميقات من الأحكام الموسّعة التي يسع المكلّف أنْ يأتي بأي لفظ شاء.
الطائفة الأولى: ما ورد فيها لفظ العمرة عند التلبية, وهي روايتان:
الرواية الأولى: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد, عن حمّاد، عن حريز, عن عبد الملك بن أعين, قال: حجّ جماعة من أصحابنا, فلمّا وافوا المدينة ودخلوا على أبي جعفر g فقالوا: إنّ زرارة أمرنا أنْ نهلّ بالحجّ إذا أحرمنا فقال لهم: (تمتّعوا). فلمّا خرجوا من عنده دخلت عليه, فقلت له: ـ جعلت فداك ـ والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة ليأتينّ الكوفة وليصبحنّ بها كذاباً، قال: (ردّهم علي). قال: فدخلوا عليه, فقال: (صدق زرارة). ثُمَّ قال: (أمَا والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني)(١٣٧).
أمّا سند الحديث فقد تقدّم بيان طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد، وهو صحيح.
وأمّا الحسين بن سعيد وحمّاد فقد تقدّم ذكرهما.
وأمّا حريز فهو السجستاني كوفي ثقة كما عن الشيخ (١٣٨) . وهو من الخامسة.
وأمّا عبد الملك بن أعين فهو وإنْ لم يرد في حقه توثيق خاصّ, ولكن ذكر الكشي بإسناده المعتبر إلى الحسن بن علي بن يقطين قال: (حدثني المشايخ أن حمران وزرارة وعبد الملك وبكيراً وعبد الرحمن بني أعين كانوا مستقيمين، ومات منهم أربعة في زمان أبي عبداللهg)(١٣٩). ويكفي هذا في حسن عبد الملك واستقامته.
وكيف كان فالرجل حسن. فتكون الرواية معتبرة.
وأمّا الدلالة فسوف نتعرّض لها بعد ذكر الرواية الثانية؛ لأنّها تنقل الحادثة نفسها.
الرواية الثانية: معتبرة إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميّسر وأناس من أصحابنا, فقال لنا زرارة: لبّوا بالحج. فدخلنا على أبي جعفرg , فقلنا له: أصلحك الله, إنّا نريد الحج, ونحن قوم صرورة فكيف نصنع؟ فقال: (لبّوا بالعمرة). فلمّا خرجنا قدم عبد الملك بن أعين, فقلت له: ألا تعجب من زرارة؟ قال لنا: لبُّوا بالحج وأنّ أبا جعفرg قال لنا لبّوا بالعمرة, فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إنّ أناساً من مواليك أمرهم زرارة أنْ يلبّوا بالحجّ عنك, وأنّهم دخلوا عليك فأمرتهم أنْ يلبّوا بالعمرة. فقال أبو جعفر g: (يريد كلّ إنسان منهم أنْ يسمع على حدة. أعدهم عليّ). فدخلنا, فقال: (لبّوا بالحجّ, فإنّ رسول الله e لبّى بالحجّ)(١٤٠).
أمّا السند فالرواية رواها الشيخ بقوله: (وعنه ـ أي الحسين بن سعيد ـ عن صفوان, عن جميل بن دراج وابن أبي نجران, عن محمّد بن حمران جميعاً, عن إسماعيل الجعفي). أيّ هناك طريقان للرواية:
الأوَّل: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن حمران.
الثّاني: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران.
وأمّا جميل بن درّاج فقد قال عنه النجاشي: (شيخنا ووجه الطائفة, ثقة)(١٤١). وهو من الخامسة.
أمّا ابن أبي نجران فهو عبد الرحمن بن أبي نجران, وهو ثقة ثقة، كما عن النجاشي(١٤٢). من السادسة.
وأمّا محمّد بن حمران فقد قال النجاشي: (أبو جعفر, ثقة)(١٤٣). من الخامسة.
وأمّا إسماعيل الجعفي فهو إمّا إسماعيل بن جابر الجعفي الذي وثّقه الشيخ قائلاً: (إسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي ثقة ممدوح له أصول)(١٤٤). والظاهر أنّ الخثعمي هو تصحيف الجعفي, فيكون الرجل ثقة, وهو من معمري الرابعة الذين أدركتهم السادسة. وإمّا هو إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي, فقد ذكر النجاشي في ترجمة بسطام ابن الحصين بن عبد الرحمن الجعفي ما لفظه: (كان وجهاً في أصحابنا وأبوه وعمومته، وكان أوجههم إسماعيل)(١٤٥). وهو أيضاً من الطبقة الرابعة, وقد روى جميل بن درّاج عن كلٍّ منهما, ومهما يكن فالرجل ثقة, فتكون الرواية معتبرة حينئذٍ.
وهذان الخبران تضمّنا الأمر للسائل بالإهلال بلفظ (العمرة إلى الحج), وأنّ التلفظ في التلبية بالعمرة ممّا يجوز, ولكن لمّا رأى الإمام g أنّ ذلك يؤدّي إلى الفساد وإلى الطعن على منْ يختصّ به من أجلّة أصحابه قال لهم لبّوا بالحج, ممّا يدلّ على أنّ الإهلال في التلبية بلفظ العمرة ممّا لا إشكال فيه وأنّه جائز شرعاً.
الطائفة الثانية ـ ما ورد فيها لفظ الحج عند التلبية ـ وهي أربع روايات:
الرواية الأولى: معتبرة زرارة قال: قلت لأبي جعفر g : كيف أتمتع؟ قال: (تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت, وصليت الركعتين خلف المقام, وسعيت بين الصفا والمروة, وقصّرت, وأحللت من كل شيء, وليس لك أنْ تخرج من مكة حتى تحجّ)(١٤٦).
أمّا سند الحديث فقد ذكر الشيخ في التهذيب: (وما رواه أيضاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين).
وهذا السند جاء تعليقاً على السند السابق له وهو عن موسى بن القاسم.
فيكون السند موسى بن القاسم, عن حمّاد بن عيسى, وطريق الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح لا إشكال فيه. وموسى بن القاسم ثقة من السابعة.
وأمّا بقية رجال السند فقد تقدّم ذكرهم.
فالرواية معتبرة السند.
وأمّا دلالة المعتبرة فهي صريحة بالتلفظ بالحجّ في التلبية عند الميقات, حيث يقول الإمام g لزرارة تأتي الوقت، أي الميقات فتلبّي بالحج ـ أيّ تتلفظ بالحج في التلبية ـ فهي من روايات التلفظ بالحجّ في التلبية.
الرواية الثانية: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم, عن صفوان بن يحيى, عن عبد الله بن مسكان, عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر g فقال لي: (بما أهللت؟). فقلت: بالعمرة. فقال لي: (أفلا أهللت بالحجّ ونويت المتعة، فصارت عمرتك كوفية، وحجتك مكية، ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين)(١٤٧).
أمّا سند الحديث فتقدّم الكلام في رجاله ومنه يظهر أنّ الرواية معتبرة.
وأمّا دلالة الرواية فالإمامg أراد بقوله: (ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحجّ) هي العمرة التي يتمتع بها إلى الحجّ, ومع ذلك ذكر الإمام g لفظ الحج عند التلبية، فهذه من الروايات التي تذكر لفظ الحج عند التلبية في الميقات.
الرواية الثالثة: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم, عن أبان بن عثمان, عن حمران بن أعين, قال: سألت أبا جعفر g عن التلبية فقال لي: (لبِّ بالحجّ فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت)(١٤٨).
أمّا السند فقد تقدّم الكلام في أغلب رجاله ما عدا أبان بن عثمان، وهو لم يرد في حقه توثيق خاصّ. ولكنّ الكشي عدّه من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم, فيمكن توثيقه بهذا الاعتبار. وهو من الخامسة.
وأمّا دلالة الرواية فهي دالّة بوضوح على أنّ التلبية عند الميقات تكون بلفظ الحجّ, فتكون من روايات الطائفة الواردة بلفظ الحجّ في التلبية.
والظاهر اتحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة.
الرواية الرابعة: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم, عن أحمد بن محمّد, قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى g كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: (لبِّ بالحجّ وانوِ المتعة, فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرتَ ففسختها وجعلتها متعة)(١٤٩).
أمّا الكلام في السند فقد تقدّم ذكر وثاقة رجاله.
وأمَّا دلالة الرواية فهي تدلّ صريحاً على أنَّ التلفظ في التلبية عند الميقات إنَّما يكون بلفظ الحجّ, فتكون من روايات الطائفة الثانية.
الطائفة الثّالثة: ـ ما ورد فيها لفظ العمرة والحج معاً ـ وهي روايتان:
الرواية الأولى: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمَّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله g: (إنَّ عثمان خرج حاجّاً فلمَّا صار إلى الأبواء أمر منادياً ينادي بالناس أجعلوها حجَّة ولا تمتعوا فنادى المنادي، فمرَّ المنادي بالمقداد ابن الأسود فقال: أمَا لتجدنّ عند القلائص رجلاً ينكر ما تقول, فلمَّا انتهى المنادي إلى علي gوكان عند ركائبه يلقمها ضبطاً ودقيقاً، فلمَّا سمع النداء تركها مضى إلى عثمان فقال: ما هذا الذي أمرت به!! فقال رأي رأيته فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله e ثُمَّ أدبر مولَّياً رافعاً صوته (لبيك بحجّة وعمرة معاً لبيك), وكان مروان بن الحكم (لعنه الله) يقول بعد ذلك فكأنِّي أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه)(١٥٠).
والكلام تارة في السند، وأخرى في الدلالة.
أمَّا السند فلم يبقَ إلَّا الحلبي لم نتعرض له وهو عبيد الله بن علي الحلبي, وقد وثَّقه النجاشي (١٥١), وهو من الرابعة. وعليه فالرواية معتبرة.
وأمَّا دلالة الرواية فهي صريحة بالتلفظ بالحج والعمرة معاً في التلبية عند الميقات فهي من روايات الطائفة الثّالثة.
الرواية الثّانية: صحيحة يعقوب بن شعيب، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله g فقلت له: كيف ترى أن أهلّ؟ فقال لي: (إنْ شئت سمَّيت, وإنّ شئت لم تسمِّ شيئاً). فقلت له: كيف تصنع أنت؟ فقال: (أجمعها فأقول لبيك بحجّة وعمرة معاً) ثمَّ قال: (أمَّا أنِّي قد قلت لأصحابك غير هذا)(١٥٢).
أمَّا السند فقد مرّ الكلام في وثاقة رجاله ما عدا يعقوب بن شعيب الذي وثَّقه النجاشي(١٥٣). وهو من الخامسة.
وأمَّا دلالة الصحيحة فهي تشير بوضوح إلى أنَّ التلفظ الذي ينبغي ذكره في التلبية عند الميقات هو الجمع بين لفظ الحجّ والعمرة، فهذه الرواية من الطائفة الثّالثة.
الطائفة الرابعة: ـ وهي التي لم يرد فيها ذكر شيء من لفظ الحجّ أو العمرة في التلبية ـ وهي روايتان:
الرواية الأولى: ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب, قال: قلت لأبي عبد الله g بأيّ شيء أهلُّ؟ فقال: (لا تسمِّ لا حجّاً ولا عمرة, وأضمر في نفسك المتعة, فإنْ أدركت متمتعاً وإلاّ كنت حاجّاً)(١٥٤).
والكلام تارة في السند، وأخرى في الدلالة.
أمَّا السند فقد تقدّم التعرض لبعض رجاله وبقي الحسن بن علي بن عبد الله فهو ابن المغيرة وثَّقه النجاشي(١٥٥), وهو من السابعة.
وفضالة بن أيوب قد وثَّقه العلمان (١٥٦) , وهو من الطبقة الخامسة.
ورفاعة بن موسى أيضاً وثَّقه العلمان(١٥٧). وهو كذلك من الخامسة.
وأبان بن تغلب ثقة، جليل القدر، كما عن الشيخ(١٥٨)وهو من الرابعة.
وعليه فالرواية معتبرة.
وأمَّا الدلالة فهي صريحة في عدم الحاجة إلى ذكر لفظ الحجّ أو العمرة في التلبية عند الميقات, فتكون من روايات الطائفة الرابعة.
الرواية الثانية: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحّام، عن منصور بن حازم قال: أمرنا أبو عبد الله g أنْ نلبّي ولا نسمِّي شيئاً، وقال: (لأصحاب الإضمار أحبّ إلي)(١٥٩).
أمَّا السند فقد تقدّم ذكر وثاقة جلّ رجاله، وبقي:
١. سيف بن عميرة وقد وثَّقه العلمان (١٦٠). وهو من الخامسة.
٢. زيد الشحّام وهو زيد بن يونس، وقد وثَّقه الشيخ(١٦١), وهو من الرابعة التي أدركتها السادسة.
٣. منصور بن حازم وهو أيضاً ثقة كما عن النجاشي(١٦٢). وهو من الطبقة الخامسة.
وعليه فالرواية معتبرة.
وأمَّا دلالة الرواية فهي تشير إلى أنَّ الإمام g أمرهم بأنْ يلبّوا من دون ذكر أيّ شيء سواء لفظ الحج أو العمرة, ممّا يكشف عن أنَّ الرواية من روايات الطائفة الرابعة.
هذه هي الطوائف الأربعة.
وأمَّا الرواية التي تشير بوضوح إلى أنَّ الإحرام لحجّ التمتع من الميقات من الأحكام الموسّعة, بحيث يسع المكلَّف أنْ يأتي بأيّ لفظ شاء فهي معتبرة: (عبد الله بن زرارة، عن أبي عبد الله g في رسالته إلى زرارة: (وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكَّة وطفت وسعيت... فهذا الذي أمرناك به حجّ التمتع، فألزم ذلك ولا يضيقنّ صدرك، والذي أتاك به أبو بصير من الإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أنْ يهلّ بالتمتع, فلذلك عندنا معانٍ وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضادّه)(١٦٣).
أمَّا سند الحديث فقد تعرّضنا له في المورد الثّاني ـ أعداد النوافل ـ, وأثبتنا اعتباره.
وأمّا الكلام في الدلالة فقد ذكر السيد الأستاذ في دلالة هذه المعتبرة ما لفظه: (فيلاحظ أنّ التلفظ بنوع النّسك لمّا كان من الموسّعات ـ إذ العبرة بالنية القلبية وهي منعقدة على عمرة التمتع, ولا أثر لكون المتلفظ به هو الحجّ, أو العمرة, أو هما معاً, أو لا يكون شيء منهما ـ فإنّ الإمامgمراعاة لبعض المصالح أمر أحد كبار أصحابه الكوفيين وهو زرارة بأنْ يلبى بالحجّ، في حين أمر أبا بصير بأنْ يُحرم بالعمرة, ولعلّ أراد لزرارة أنّ يشبه حجّه حجّ صحابة النبي e في حجة الوداع, حيث إنّهم أحرموا بالحج ثُمَّ عدلوا إلى عمرة التمتع)(١٦٤).
ونزيد على كلام الأستاذ أنّ التلفظ بنوع النّسك لو كان له مدخلية في الحكم الواقعي وأنّه يلزم الإخلال بالحكم الواقعي لو أتى بغير ما هو واجب عليه لمّا صح للإمام g أنْ يأمر زرارة بأنْ يتلفظ بالحجّ, ويأمر أبا بصير بالتلفظ بالعمرة, وهذا يكشف بوضوح عن أنّ التلفظ بنوع النّسك لمّا كان من الموسّعات وأنّ المكلّف في سعة من أمره فمن ثَمَّ اختلف كلام الإمام g.
والشاهد عليه قول الإمام g : (فلذلك عندنا معانٍ لذلك ما يسعنا ويسعكم), أيّ لولا وجود معانٍ وتصاريف يمكن أنْ يحمل كلامنا عليها بحيث تكون هناك من السعة علينا وعليكم ما اختلف كلامنا بالنسبة إلى كيفية الإحرام, واختلف التلفظ بنوع النّسك.
وأيضاً يشهد على ذلك ذيل الرواية حيث ذكر الإمام g: (ولا يخالف شيء من ذلك الحق, ولا يضادّه), وهذا الكلام من قِبل الإمام g يشهد أنّ كُلّا من التلفظ بالحجّ أو العمرة صحيح, ولكن رعاية لبعض المصالح, كأنْ يكون الفضل في بعضها أكثر فأمر الإمامgزرارة بشيء يخالف ما أمر أبا بصير به, كأنْ تكون المصلحة ما ذكرها السيد الأستاذ من أنّ الإمام g أراد لزرارة أنْ يشبه حجّه حجّ صحابة النبي e في حجّة الوادع, حيث إنّهم احرموا بالحجّ ثُمَّ عدلوا إلى عمرة التمتع.
والحاصل في هذا المورد: إنّ اختلاف الروايات الواردة عن أهل البيت i ـ وأنّ في بعضها يأمر الإمام g بعدم ذكر شيء من الحجّ أو العمرة, وفي بعضها الآخر يأمر بذكر لفظ الحجّ أو العمرة ـ يكشف عن أنّ التلفظ بنوع من الموسّعات التي لو لم يأتِ بها المكلّف لا يغيّر ذلك بالحجّ مادامت النية القلبية منعقدة عن ذلك النّسك, ولكن رعاية لبعض المصالح يأمر الإمام g بالإهلال بالحجّ, وأحياناً يأمر بالإهلال بالعمرة, وفي كلا الموردين يكون الحكم مجزياً.
المورد الخامس
من موارد اختلاف الأخبار في الأحكام الموسّعة
هو ما ورد في إدراك حدّ المتعة
اختلفت الروايات الواردة عن أهل البيت i في حدّ إدراك المتعة اختلافاً شديداً, فقد كان الأئمة iيأمرون أصحابهم بوجوه مختلفة لبعض المصالح كإيقاع الخلاف مثلاً، وأنْ لا يظهروا على رأي واحد وأنّهم تحت قيادة واحدة، أو لأجل المداراة والتخفيف، أو لأجل زيادة الفضل والثواب, أو لغيرها من المصالح ممّا اقتضى أنْ يكون الأمر على أنحاء مختلفة.
وأيّاً كان, فلنتعرّض لهذه الروايات التي هي على طوائف مختلفة لنرى مدى الاختلاف الوارد عن الأئمة i.
الطائفة الأولى: ما دلّ على إدراك المتعة إلى طلوع الفجر من يوم التروية وذهابها بعده, وهي عدّة روايات:
الرواية الأولى: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن عيسى ـ وهو أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا g عن المرأة تدخل مكة متمّتعة فتحيض قبل أنْ تحل متى تذهب متعتها؟ قال: (كان جعفر g يقول: زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى g يقول: صلاة الصبح من يوم التروية) فقلت: جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية, ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحجّ فقال: (زوال الشمس). فذكرت له رواية عجلان بن أبي صالح قال: (لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة). فقلت: فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحج؟ فقال: (لا، هي على إحرامها) . فقلت: فعليها هدي؟ فقال: (لا، إلّا أنْ تحبّ أنْ تطوّع) ثم قال: (أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أنْ نحرم فاتتنا المتعة)(١٦٥).
والمقصود برواية عجلان أبي صالح هو ما رواه الكليني بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ـ وهو ابن بزيع ـ عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله g عن امرأة متمتعة قدِمت مكة فرأت الدم، قال: (تطوف بين الصفا والمروة, ثم تجلس في بيتها، فإنْ طهرت طافت بالبيت. وإنْ لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحجّ من بيتها, وخرجت إلى منى, وقضت المناسك كلها, فإذا قدِمت مكة طافت بالبيت طوافين, ثم سعت بين الصفا والمروة. فإذا فعلت فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها)(١٦٦).
ورواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع صحيحة ـ كما ذكرنا ـ وقد تقدّم حال رجالها بما لا حاجة إلى تكراره.
والكلام في دلالة الحديث هو:
أنّ الملاحظ أنّ الإمام الرضا g أجاب عن سؤال محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حدّ إدراك المتعة بنقل كلامين مختلفين عن جدّه وأبيه h ولم ينقلهما بصيغة رُوي ليُحمل أحد النقلين أو كلاهما على عدم الصحة، بل مع الجزم بالنسبة حيث قال: (كان جعفر g يقول... وكان موسىg يقول...)، فهو ـ أي الإمام الرضا g ـ نسب بصيغة الجزم إلى الإمامين الصادق والكاظم h، وهذا ليس له محمل صحيح إلّا أنْ يكون الحدّ لإدراك المتعة من الموسّعات التي يكون التشريع فيها ذا سعةٍ, وأنّ ما صدر من الأئمة i يكون مراعاة لبعض المصالح: إمّا لبيان الفرد الأفضل, أو لأجل المداراة, أو لغير ذلك من المصالح التي ذكرناها سابقاً.
نعم, الرواية ظاهرة في أنّ الحدّ الأقصى لإدراك المتعة هو زوال الشمس من يوم التروية؛ لأنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع حاول انتزاع الترخيص في الإتيان بعمرة التمتع فيما بعد ذلك من خلال الإشارة إلى رواية عجلان أبي صالح, إلّا أنّ الإمام الرضا g لم يُجز ذلك, ولكن بقرينة الروايات التي سوف نستعرضها من خلال الطوائف الأخرى تُحمل الرواية على خلاف ظاهرها, وأنّ الإمام الرضا g إنّما اقتصر على كون الحدّ الأقصى لإدراك المتعة هو زوال الشمس من يوم التروية لأجل بعض المصالح والأغراض, مثل أنْ لا يتأخّر المكلّف ويتهاون فيفوته الحجّ.
والخلاصة: إنّ الصحيحة فيها دلالة واضحة على أنّ حدّ إدراك المتعة من الأحكام الموسّعة بحيث يمكن للمكلف أنْ يأتي بأعمال عمرة التمتع في أوقات مختلفة ولا يتحدّد بوقت معين.
نعم، يجب أنْ لا يتأخّر إلى وقت لا يستطيع أنْ يأتي بأعمال العمرة, وهو زوال يوم عرفة كما سيأتي في الروايات اللاحقة.
الرواية الثّانية: صحيحة جميل بن دراج وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله g عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال:
(تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة, ثمّ تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة)(١٦٧). قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة.
وسند الرواية صحيح، وقد تقدّمت ترجمة الجميع ما عدا فضالة وهو فضالة بن أيوب الأزدي قد وثّقه العلمان(١٦٨) ـ النجاشي والطوسي ـ , وهو من الخامسة روى عنه رجال السادسة.
وهناك قول بأنّ رواية الحسين بن سعيد عن فضالة كلّها بواسطة أخيه الحسن بن سعيد. وليس في ذلك أهمية كبيرة في روايتنا هذه طالما أنّ السند بالإضافة إلى فضالة يوجد صفوان وابن عمير وهما ممّن روى عنهما الحسين بن سعيد, فلا إشكال في السند من هذه الجهة.
وأمّا الكلام في دلالة الحديث فإنّ جميل بن دراج سأل الإمام الصادق g عن قدوم المرأة الحائض لمكة يوم التروية, وهذا يعني أنّ قدومها بعد طلوع الفجر ـ ولو بدقائق قليلة ـ حيث يصدق عليه أنّه يوم التروية, ومِن ثَمَّ تذهب متعتها بعد طلوع الفجر من يوم التروية, ممّا يكشف أنّ هذه الرواية هي من الطائفة الأولى التي جعلت حدّ المتعة هو طلوع الفجر من يوم التروية, إذ نلاحظ أنّ الإمام g أمر أنْ تجعل حجّها حجّ إفرادٍ, وتأتي بعمرة مفردة بعد الحجّ إنْ تمكنت.
هذا، وهذه الصحيحة لا تنافي ما سيأتي من الروايات التي تجعل حدّ المتعة زوال يوم التروية أو فجر يوم عرفة؛ لاحتمال أنّ الإمام g عَلِم أنّ هذه المرأة لا تطهر إلى ما بعد زوال يوم عرفة, وحينئذٍ يكون حجّها إفراداً.
والحاصل: من هذه الطائفة: إنّ حدّ المتعة هو طلوع الفجر من يوم التروية, بحيث لا تصحّ المتعة في غير هذا الوقت. ولكن بقرينة الروايات الآتية من أنّ حدّ المتعة يستمر إلى فجر يوم عرفة وإلى الزوال من يوم عرفة سيتضح أنّ هذا الحكم الذي ورد عن أهل البيت i من الأحكام الموسّعة التي يكون فيها سعة في التشريع, فليس مخالفتها توجب مخالفة الحكم الواقعي بحدِّه لفرض أنّها لم تصدر لبيان الحكم الواقعي, بل كان الاقتصار على بعضها لأجل بعض المصالح. إلّا أنّ هذا الاقتصار لا يعني أنّ مخالفة بعضها يؤدّي إلى مخالفة الحكم الواقعي.
الطائفة الثانية: ما دلّ على إدراك المتعة إلى زوال الشمس من يوم التروية بحيث تفوت المتعة, ولا تصحّ بعد الزوال من يوم التروية، وهي صحيحة محمّد بن إسماعيل ابن بزيع المتقدّمة التي حكى الإمام الرضا g عن جدّه الصادق g أنّ متعة الحائض تذهب بزوال الشمس من يوم التروية حيث قال: (كان جعفر g يقول زوال الشمس من يوم التروية) (١٦٩).
وقد أكد الإمام g هذا المعنى ـ كون حدّ المتعة إلى زوال الشمس من يوم التروية ـ مرّتين: (مرة) في قوله: (وجُعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال: زوال الشمس).
(وأُخرى) حين ذكر له السائل رواية عجلان أبي صالح فأجابه g: (لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة).
وعليه, فهذه الرواية تدلّ على أنّ حدّ المتعة هو زوال الشمس من يوم التروية, فتكشف ـ كما مرّ آنفاً ـ عن أنّ حكاية الإمامg لقول أبيه الإمام الكاظم g ليس لبيان الحكم الواقعي, وأنّه على حدّ الإلزام. وإلّا ـ لو كان على نحو الإلزام ـ لكان ذكره لقول جدّه الصادق وكذلك كلامه h يكون مخالفاً للواقع, وهذا ممّا نستبعده، بل نمنعه, ممّا يكشف عن أنّ ذكر حدّ المتعة من أنّها إلى زوال يوم التروية يكون من الأحكام الموسّعة. واقتصار الإمام الكاظم g على فجر يوم التروية إنّما كان لمصلحة من قبيل حثّه على المبادرة وعدم التهاون, لأجل أنْ لا يفوته الحجّ.
والحاصل: من هذه الطائفة أنّ كون حدّ المتعة هو زوال يوم التروية يكشف عن كون جعل حدّ المتعة هو فجر يوم التروية لم يكن من الإلزام، وإلّا لاستلزم أن يكون جعل حدّ المتعة هو زوال الشمس من يوم التروية مخالفاً للواقع، وهذا ممتنع.
الطائفة الثالثة: ما دلّ على إدراك المتعة إلى غروب الشمس من يوم التروية, وعدم إدراكها بعد ذلك، وهي روايتان:
الأولى: صحيحة عيص بن القاسم وهي ما رواها الشيخ بقوله: وعنه ـ أي موسى ابن القاسم لأنّه المتقدم في الرواية السابقة ـ عن صفوان, عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله g عن المتمتع يقدِم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: (لا، له ما بينه وبين غروب الشمس). وقال: (قد صنع ذلك رسول الله e)(١٧٠).
والرواية صحيحة السند لوثاقة جميع رجالها، وقد تقدمت ترجمتهم عدا العيص بن القاسم، فقد قال عنه النجاشي S: (عيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران البجلي كوفي عربي يكنى أبا القاسم ثقة) (١٧١). وهو من الخامسة.
وعليه تكون الرواية صحيحة السند لوثاقة جميع رواتها.
وأمّا الكلام في الدلالة فقد ذكر السيد الأستاذ (١٧٢) أنّ في ذيل الصحيحة إشكالاً، لأنّ من المسلّم أنّ النبي e لم يحجّ تمتعاً؛ فإنّ المتعة نزلت في حجّة الوداع, وهو e كان قارناً, ولم يكن بإمكانه العدول إلى المتعة.
إلّا أنّ ذلك لا يمنع دلالة الرواية على كون حدّ إدراك المتعة هو غروب الشمس من يوم التروية ممّا تكشف عن أنّ ما ذكره الإمام الرضا g, وكذلك الإمام الكاظم g لم يكن لبيان الحكم الواقعي بحدِّه ـ وإلّا لاستلزم أنْ يكون ما ذكر في هذه الصحيحة ليس بصحيح مع أنّها تامّة السند. وأيضاً هي واضحة الدلالة على كون حدّ إدراك المتعة هو غروب الشمس من يوم التروية ـ وإنّما اقتصر الإمام g في الروايات السابقة على فجر يوم التروية, أو زوال الشمس من يوم التروية لأجل بعض المصالح التي ذكرنا بعضها في الكلام السابق. وعليه تكون هذه الرواية أيضاً كاشفة عن كون حدّ إدراك المتعة من الأحكام الموسّعة التي يكون التشريع فيها موسعاً, بحيث يمكن للمكلّف أنْ يأخذ بأيّهما شاء.
الثانية: ما رواه الشيخ بقوله: عنه ـ أي موسى بن القاسم لفرض أنّه المتقدّم ـ عن محمّد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله، قال: سألت أبا الحسن موسى g عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال: (للمتمتع ما بينه وبين الليل)(١٧٣).
أمّا سند الرواية: فقد تقدم الكلام في موسى بن القاسم وفي طريق الشيخ إليه.
وأمّا محمّد بن سهل فقد ذكره النجاشي(١٧٤), ولكنّه لم يوثّقه. وكذلك ذكره الشيخ (١٧٥) في الفهرست وأيضاً لم يوثقه. فالرجل لم يوثّق, وهو من السادسة.
وأمّا أبوه فهو سهل بن اليسع بن عبد الله, قال النجاشي S(١٧٦) سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الأشعري قمي ثقة من الخامسة.
وأمّا إسحاق بن عبد الله فقد قال النجاشي S(١٧٧) إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري قمي ثقة, وهو من كبار الخامسة.
وعليه تكون الرواية ضعيفة بمحمّد بن سهل؛ لأنّه لم يوثّق في كتب الرجال. ولكن لا يضرّ ضعف سندها في المقام مع وجود رواية صحيحة السند تدلّ على أنّ حدّ إدراك المتعة هو غروب الشمس, وعندئذٍ تكون هذه الرواية صالحة لتأييد أنّ حدّ المتعة من الأحكام الموسّعة.
وأمّا الكلام في دلالة الرواية فمن الواضح أنّ الإمام الكاظم g عندما سئل عن المتمتع الذي يدخل يوم التروية كان جوابه g للمتمتع ما بينه وبين الليل, بمعنى أنّ المتمتع يمكن له أنْ يدرك المتعة قبل غروب الشمس من يوم التروية. وكلام الإمام الكاظم g لو كان لبيان الحكم الواقعي بحدِّه ـ أي أنّه على حدّ الإلزام بحيث لا يجوز التخلّف عنه ـ لكان منافياً لما حكاه الإمام الرضاg عن الإمام الكاظم gمن كون حدّ إدراك المتعة هو فجر يوم التروية, والذي يرفع هذا التنافي هو أنْ نحمل كلام
الإمام g على أنّ اقتصاره على غروب يوم التروية لإدراك المتعة لم يكن صادراً لبيان الحكم الواقعي بحدِّه بحيث لا يجوز التخلّف عنه, بل نحمله على كون حدّ إدراك المتعة من الأحكام الموسّعة, فلا يُلزَم المكلّف ببعضها دون بعض. وأمّا اقتصار الإمام g على بعض الموارد: فإمّا رعاية لبعض المصالح كأنْ لا يتهاون المكلّف في التأخير, أو من باب المداراة لبعض المكلّفين الذين لديهم ضعف أو غير ذلك.
وكيف كان, فهذه الرواية كسابقتها تكشف عن كون حدّ إدراك المتعة من الأحكام الموسّعة.
الطائفة الرابعة: ما دلّ على إدراك المتعة إلى وقت السحر من ليلة عرفة وعدم إدراكها بعد ذلك، وهي صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله g إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: (إلى السّحر من ليلة عرفة)(١٧٨).
والرواية واردة في التهذيب هكذا: (موسى بن القاسم عن حسن عن علا بن رزين عن محمّد بن مسلم). وقد تقدّم الكلام في صحّة طريق الشيخ S إليه, كما تقدّم ذكر وثاقته وطبقته.
وأمّا (حسن) فقد ذكر السيد الخوئي S في المعجم: (الحسن الراوي لكتاب العلاء يمكن أنْ يراد به الحسن بن محبوب, أو ابن فضال ـ كما سيأتي في كلام الشيخ ـ.ويمكن أنْ يراد به الحسن بن زياد الوشاء ... ـ إلى أن قال ـ وقال الشيخ: العلاء بن رزين القلاء ثقة جليل القدر له كتاب وهو أربع نسخ (منها) : رواية الحسن بن محبوب)(١٧٩).
وجميع هؤلاء أي الحسن بن محبوب أو الحسن بن فضال أو الحسن بن زياد الوشاء من الطبقة السادسة؛ لأنّ العلاء بن رزين من الطبقة الخامسة فالطبقة تساعد، وجميع هؤلاء من الثقات.
وأمّا العلاء بن رزين فقد قال النجاشي S(١٨٠) العلاء بن رزين القلّاء, ثقفي مولى ـ إلى أنْ قال ـ وكان ثقةً, وجهاً, وقد مرّ آنفاً كلام الشيخ في حقّه الذي حكاه عنه السيد الخوئي S في المعجم، وهو من الخامسة.
وأمّا محمّد بن مسلم فقد قال عنه النجاشي :S (محمّد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الأوقص الطحّان، مولى ثقيف الأعور، وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه، ورع)(١٨١). وهو من الرابعة، وعليه تكون الرواية صحيحة السند لوثاقة جميع رواتها.
وأمّا الكلام في الدلالة فقد ذكر السيد الأستاذ : (السّحر هو: الثلث الأخير من اللّيل فإنْ كانت الغاية داخلة في المغيّى دلّت الصحيحة على جواز الإتيان بعمرة التمتع إلى طلوع الفجر من ليلة عرفة، وإنْ كانت خارجة عنه دلّت على جواز الإتيان بها في الثلثين الأولين من اللّيل فقط)(١٨٢).
وهذه الصحيحة تصلح شاهداً لكون حدّ إدراك المتعة هو السّحر فيما لو كان المراد من (العمرة) في سؤال الراوي هو عمرة التمتع, وهذا هو الذي فهمه الشيخ في الاستبصار(١٨٣) فإنّه جعل الصحيحة في عداد الروايات الواردة في حدّ إدراك المتعة.
وهذه الصحيحة تدل على أنّ وقت إدراك المتعة متسع, ولا ينحصر في وقت معين كالفجر من يوم التروية أو الزوال من يوم التروية. وإلّا لكانت تلك الروايات صادرة لبيان الحكم الواقعي بحدِّه, وهذا يستلزم منافاته للروايات السابقة ممّا لا يمكن دفعه إلّا بالحمل على كون إدراك المتعة من الأحكام الموسّعة التي يكون فيها التشريع موسّعاً, فلا يُلزَم المكلّف ببعضها دون بعض.
الطائفة الخامسة: ما دلّ على إدراك المتعة بإدراك الحجاج بمنى, وعدم إدراكها مع عدم إدراكهم فيها.
ومن المعروف أنّ إدراك الحجاج في منى إنّما يتحقّق من طلوع الفجر ليوم عرفة إلى طلوع الشمس وبعده من يوم عرفة؛ لأنّ الناس يبيتون ليلة عرفة بمنى, ويتوجّهون إلى عرفات من بعد طلوع الفجر ليوم عرفة, أو من بعد طلوع الشمس ليوم عرفة, ويستمر نزوحهم إلى عرفات إلى قبيل الزوال, فيكون إدراك الناس بمنى من طلوع الفجر ليوم عرفة وما بعده.
وهذه الطائفة مجموعة روايات:
الأولى: صحيحة الحلبي وهي ما رواه الشيخ بقوله: موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله g قال: (المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى)(١٨٤).
تقدم الكلام في بعض رجال سند هذه الرواية وبقي: حمّاد فهو حمّاد بن عثمان الغاب؛ فإنّ ابن أبي عمير وإنْ روى عن حمّاد بن عيسى إلّا أنّ رواياته عن حمّاد بن عثمان
بلغت ثمانية وستين مورداً كما ذكر السيد الخوئي S في المعجم (١٨٥) .
وكيف كان, فإنّ الرجلين ممّن وُثّقا من قِبل العلمين, فلا إشكال من هذه الجهة.
وأمّا الحلبي فهو عبيد الله بن علي الحلبي, قال النجاشي S: (عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي مولى بني تميم ـ إلى أن قال ـ وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا ـ إلى أن قال ـ وكان جميعهم ثقات مرجوعاً إلى ما يقولون وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم)(١٨٦).
والحاصل: إنّ الرواية صحيحة لوثاقة جميع رواة السند.
وأمّا الكلام في الدلالة، فمن الواضح أنّ الرواية تدلّ على أنّ حدّ إدراك المتعة هو إدراك الناس بمنى, وهذا يعني أنّه يستمر وقت إدراك المتعة إلى ما قبل الزوال من يوم عرفة، أو قبل ذلك بقليل؛ لأنّ الناس يبدأون بالإفاضة من بعد طلوع الفجر, وتستمر إفاضتهم: فبعضهم قد يفيض بعد طلوع الشمس بوقت ـ كأن يكون ساعة أو أكثر ــ .
وكيف كان: فالرواية دالّة على أنّ وقت المتعة يستمر إلى نهار يوم عرفة قبل الزوال، وهذا الوقت إذا التزمنا به على أنّه لا تجوز مخالفته بحيث يكون من باب الإلزام لاستلزم ذلك أنْ يكون منافياً لما ورد من الروايات السابقة من كون حدّ إدراك المتعة فجر يوم التروية، أو زوال يوم التروية، أو سحر ليلة عرفة, مع أنّها صحيحة السند وكذلك واضحة الدلالة على كون إدراك المتعة يكون في هذا الوقت المحدّد, يكشف عن أنّ وقت إدراك المتعة من الأحكام الموسّعة التي يكون فيها الوقت ممتدّاً وغير محدّد بوقت خاصّ, فإذا ورد في بعض الروايات التحديد بوقت خاصّ كالصحيحة هذه ـ وكذلك الروايات الآتية التي سوف نذكرها في هذه الطائفة ـ فإنّما يكون لرعاية بعض المصالح كالتخفيف على المكلّف وعدم التضييق عليه ـ مثلاً ـ , أو لأجل بعض المصالح الأخرى التي يراها الإمام g.
والكلام نفسه يأتي في الروايتين الآتيتين الّتين تحدّدان الوقت لإدراك المتعة بإدراك الناس بمنى.
الثّانية: صحيحة مرازم بن حكيم وهي ما رواه الشيخ بقوله: سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم، قال: قلت لأبي عبد الله g المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة حائض، حتى متى يكون لهما المتعة؟ فقال: (ما أدركوا الناس بمنى)(١٨٧).
وتقدم الكلام في بعض رجال السند وبقي:
١. أحمد بن محمّد بن أبي نصر فهو كوفي ثقة بلا خلاف، وهو أحد الثلاثة ـ ابن أبي عمير وصفوان ـ الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة, وأحد أصحاب الإجماع الستة في الطبقة السادسة.
٢. ومرازم بن حكيم قال النجاشي S مُرازم بن حكيم الأزدي المدائني مولى ثقة(١٨٨). وهو من الخامسة.
وأمّا الكلام في الدلالة فهو نفس ما مرّ في الرواية السابقة.
الثالثة: صحيحة هشام بن سالم ومرازم وشعيب وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله g عن الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحلّ ثم يحرم ويأتي منى؟ قال:
(لا بأس)(١٨٩).
وتقدم الكلام في بعض رجال السند وبقي:
١. هشام بن سالم وقد قال النجاشي S: (هشام بن سالم الجواليقي ـ إلى أنْ قال ـ روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن h ثقة ثقة)(١٩٠). وهو من الخامسة.
٢. وشعيب وهو ابن يعقوب العقرقوفي ، قال النجاشي :S (أبو يعقوب ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن h ثقة, عين)(١٩١).وهو من الخامسة.
وعليه تكون الرواية صحيحة لوثاقة جميع رواتها.
والصحيحة ذكرت أنّ الرجل المتمتع بعد أنْ يكمل الأعمال لعمرة التمتع يذهب إلى منى, ولم تحدّد الوقت وإنْ كان بحسب الغالب يكون ذهاب المتمتع إلى منى ليلة عرفة, إلّا أنّ الصحيحة مطلقة وهي تشمل ما لو كان وصوله إلى منى بعد طلوع الشمس. وعليه تكون هذه الرواية من الروايات الدالّة على أنّ حدّ إدراك المتعة هو إدراك الناس بمنى, فهي تدل أيضاً ـ كما ذكرنا في الرواية الأولى ـ على أنّ التحديد بإدراك الناس بمنى ليس من باب الإلزام, وإلّا لكان منافياً مع ما مرّ من الروايات السابقة, وإنّما يكون التحديد من باب الموسّعات التي يكون التشريع فيها ذا سعة بحيث يمكن للمكلّف فيها أنْ لا يتحدّد بوقت محدّد, بل يجوز له التأخير, إلّا أنْ يستلزم فوات الوقت لعمرة التمتع كما سنذكره في الروايات الآتية.
والحاصل: إنّ هذه الطائفة لا تنافي ما ذُكر في الطوائف السابقة فيكون التحديد بإدراك الناس بمنى لأجل بعض المصالح التي لاحظها الإمام g كأنْ يكون من قبيل التخفيف وعدم التضييق على المكلّف ما دام الوقت متسّعاً, ويمكن للمكلّف أنْ يكمل عمرة التمتع اذا لم يفت وقتها المحدد في الروايات الآتية.
وفي ختام هذه الطائفة نذكر كلاماً للسيد الأستاذ حول هذه الطائفة, حيث قال: (وهنا سؤال وهو: هل أنّ إدراك الناس بمنى لوحظ في هذه الروايات على نحو الموضوعية, أو على نحو الطريقية إلى إدراك الوقوف الاختياري في عرفات في تمام الوقت الواجب، لوضوح أنّ من يدرك النّاس في منى يدرك الوقوف الاختياري في عرفات في تمام الوقت اللازم؟ فيه وجهان:
وقد يُرجّح الثاني بقرينة أنّ الكون في منى قبل الوقوف في عرفات ليس واجباً, فمقتضى مناسبات الحكم الموضوع أنْ يكون إدراك الناس بمنى ملحوظاً على نحو الطريقية إلى إدراك الوقوف الاختياري بعرفات في تمام الواجب.
ولكن هذا ليس بواضح، فإنّه كما أنّ التحديد بطلوع الفجر، أو زوال الشمس، أو غروبها من يوم التروية، أو بالسّحر من ليلة عرفة مبني على الموضوعية؛ لوضوح أنّ إدراك الوقوف الاختياري في عرفة لا يتوقف على الانتهاء من أعمال عمرة التمتع إلى هذه الأوقات, كذلك يحتمل أنْ يكون إدراك الناس بمنى قبل توجّههم إلى عرفات مبنيّاً على الموضوعية, وهو مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ في النصوص المذكورة فلا معدل عنه إلّا بقرينة)(١٩٢).
فالسيد الأستاذ يشير إلى أنّ عنوان (إدراك النّاس بمنى) ملحوظ بنفس لحاظ باقي العناوين الأُخرى.
الطائفة السادسة: وهي ما دلّ على أنّ إدراك المتعة يكون إلى زوال الشمس من يوم عرفة دون ما بعد ذلك, وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله, عن محمّد بن عيسى, عن ابن أبي عمير, عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله g قال: (والمتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر)(١٩٣).
والرواية صحيحة وقد تقدم الكلام في ترجمة جميع رجال السند.
وأمّا الكلام في الدلالة فمحل الشاهد هو المقطع الأوَّل وهو ظاهر في أنّ من انتهى من أعمال عمرة التمتع في مكة قبل زوال الشمس من يوم عرفة يكون قد أدرك المتعة, بخلاف من لم ينتهِ منها حتّى الزوال.
وعليه فالصحيحة تدلّ على أنّ حدّ إدراك المتعة هو زوال الشمس من يوم عرفة, ولكن هذا لا ينافي ما ورد في الطوائف الأخرى من كون حدّ إدراك المتعة هو فجر يوم التروية، أو زوال يوم التروية، أو السحر من يوم التروية؛ لأنّ هذه الصحيحة إنّما تنافي ما سبق من الروايات لو كانت تلك الروايات بصدد بيان الحكم الواقعي بحدِّه وأنّها تُلزم الرجل المتمتع بأنْ يدرك المتعة قبل فجر يوم التروية ـ مثلاً ـ .
ولكن ذكرنا غير مرَّة أنّ هذا ليس بتام؛ فإنّ هذه الروايات لم تكن بياناً للحكم الواقعي بحدِّه, وإنّما ذُكرت لأجل بعض المصالح, وأنّ حدّ إدراك المتعة من الأحكام الموسّعة التي يكون التشريع فيها موسّعاً, بحيث لا تُلزم المكلّف بخصوص أيّ واحدة من تلك التحديدات، وعليه يكون اقتصار الإمام g على كون حدّ إدراك المتعة هو الزوال من يوم عرفة لأجل بعض المصالح التي لاحظها g كالتخفيف وعدم التضييق على المكلّف, وإلّا فإنّه سوف يأتي في الطائفة الأخيرة أنّ الوقت يمتدّ إلى زمانٍ يمكنه إدراك مسمّى الوقوف.
الطائفة الأخيرة: ما قيل بدلالتها على إدراك المتعة مع إدراك الوقوف الاختياري: إمّا بتمامه أو الوقوف الركني ـ أي مسمّى الوقوف ـ.
وهذه الطائفة هي مجموعة من الروايات تصل إلى خمس روايات, وجميع هذه الروايات قد نوقش في دلالتها على هذا المعنى(١٩٤).
ولنأخذ رواية واحدة لنرى مدى عدم دلالتها, وهي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله g: عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعاً, ثمّ قَدِم مكة والناس بعرفات, فخشي إنْ هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أنْ يفوته الموقف. فقال: (يدع العمرة فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه)(١٩٥).
والسند هو ما رواه الشيخ بإسناده عن (ابن أبي عمير, عن حمّاد, عن الحلبي). والرواية صحيحة لصحّة طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير, وباقي رجال السند من ثقات الإمامية.
وأمّا الكلام في دلالة الصحيحة فقد ذكر السيد الأستاذ أنّ من المحتمل أن يكون مراد السائل بقوله: (والناس بعرفات) هو كون الحجاج بعرفات في صباح يوم
عرفة بعد خروجهم إليها من منى ـ كما هو السائد المتعارف من أنّهم يبيتون ليلة عرفة في منى, ويتوجّهون إلى عرفات بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الشمس ـ وعلى ذلك فما يستفاد من قوله: (فخشي إنْ هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أنْ يفوته الموقف) هو أنّه كان يبني على إدراك المتعة مع الإتيان بأعمال العمرة قبل ظهر يوم عرفة مع عدم خوف فوت الموقف في عرفات, وأمّا مع خوف فوت الموقف فكان جاهلاً بحكمه فسأل الإمام g عنه(١٩٦).
وعليه لا تدل هذه الصحيحة على كون حدّ إدراك المتعة هو إدراك المسمّى من الوقوف بعرفات، وكذلك باقي الروايات أيضاً فيها مناقشة, فيكون الحدّ لإدراك المتعة الذي لا يجوز تجاوزه هو الزوال من يوم عرفة, فإذا أنهى أعمال عمرة تمتعه قبل الزوال من يوم عرفة فقد أدرك المتعة, وإلّا ـ أيْ إنْ لم يمكنه إنهاء أعمال عرفة قبل الزوال من يوم عرفة ـ لا يمكن له أنْ يدرك المتعة, ويعدل إلى حجّ الإفراد.
وخلاصة هذا المورد:
إنّك ترى أنّ هذا المورد الذي نحن بصدده قد وردت فيه طوائف كثيرة من الروايات، فقد ورد إدراك المتعة عند فجر يوم التروية، وزوال يوم التروية، والسّحر من ليلة عرفة، وإدراك الناس بمنى, وكذلك الزوال من يوم عرفة، وعليه فيمكن عدّ حدّ إدراك المتعة من الموسّعات، فإنّ الحكم الواقعي في المسألة هو جواز العدول إلى حجّ الإفراد فيما إذا لم يتمكن من إكمال عمرة التمتع من فجر يوم التروية إلى الزوال من يوم عرفة، وأمّا إذا تمكن من إكمال عمرته في هذا الوقت ـ أي قبل الزوال من يوم عرفة ـ فيمكنه أنْ يتمّ عمرته, ولا إشكال في ذلك هذا هو الحكم الواقعي، ولكن لفرض أنّ حدّ إدراك المتعة كان من الموسّعات التي يكون التشريع فيها ذا سعةٍ, فإنّ الأئمة i يأمرون أصحابهم بوجوه مختلفة، مثل: أنْ يأمر الإمام g بأنّ حدّ إدراك المتعة هو الفجر من يوم التروية فلا يمكن إدراكها بعد ذلك، أو أنْ يأمر الإمام g بأنّ حدّ إدراك المتعة هو السّحر من ليلة عرفة ولا يمكن إدراك المتعة بعد ذلك وغيرها ممّا مرّ في الروايات السابقة، وكان أمر الأئمة i بهذه الوجوه لبعض المصالح التي كان يلحظها الأئمة iكأنْ يكون من قبيل إيقاع الخلاف بين الشيعة؛ ليعطي انطباعاً لدى السلطة الظالمة بأنّهم ليسوا بجماعة منظّمة وموحّدة من قبل قيادة واحدة, أو من قبيل التشديد على المكلفين من أجل أنْ لا يجعل لديهم تهاوناً ممّا يؤدّي إلى فوت الحج، إلى غير ذلك من المصالح. ولا يلزم أنّ أمر الأئمة i بهذه الوجوه لاختلاف درجات الفضل؛ فإنّه قد يكون الجميع على درجة واحدة, ولكن المصلحة التي كان يلحظها الإمام g هي التي دفعته إلى الأمر بذلك الوجه.
والحاصل: إنّ تحديد إدراك المتعة من الأحكام الموسّعة التي يكون التشريع فيها موسّعاً بحيث لا يتقيّد المكلّف بوقت واحد.
نعم, لا يجوز أنْ يؤخّر أعمال عمرته إلى وقت زوال الشمس من يوم عرفة؛ فإنّه تفوت المتعة عند زوال الشّمس من يوم عرفة.
هذا ما أردنا بيانه في موارد الأحكام الموسعة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلّى الله على خير خلقه محمّداً وآله الطيبين الطاهرين.
المصادر
- القرآن الكريم.
- اختيار معرفة الرجال للشيخ أبي جعفر الطوسي S, مؤسسة النشر الإسلامي، تحقيق جواد القيومي.
- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للشيخ محمّد بن الحسن الطوسي S , مطبعة النجف.
- بحار الأنوار، العلامة المجلسي O ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان, الطبعة الثالثة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- بحوث في شرح مناسك الحج, تقريرٌ لأبحاث السيد محمّد رضا السيستاني , بقلم: الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف, نسخة أوَّليَّة محدودة التداول.
- تعارض الأدلة واختلاف الحديث, تقريرات بحث سماحة السيد السيستاني F, بقلم: السيد هاشم الهاشمي .
- تهذيب الأحكام في شرح المقنعة لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي S , دار الكتب الإسلامية.
- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة للشيخ يوسف البحراني, دار الكتب الإسلامية النجف الأشرف.
- خاتمة المستدرك للمحدث النوري, تحقيق مؤسسة آل البيت i لإحياء التراث.
- خلاصة الأقوال للعلامة الحلي O, الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة, طبعة مؤسسة النشر الإسلامي, الطبعة الأولى, سنة ١٤١٧ هـ.
- رجال النـجاشي للشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد النـجاشي O, مـؤسسة النشر الإسلامي.
- عدّة الأُصول للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي O، تحقيق الشيخ محمّد مهدي نجف , مؤسسة آل البيت i لإحياء التراث.
- الفهرست للشيخ محمّد بن الحسن الطوسي S, تحقيق جواد القيّومي.
- قبسات من علم الرجال, أبحاث السيد محمّد رضا السيستاني , جمعها ونظّمها السيد محمّد البكاء, نسخة أوّليّة محدودة التداول, ١٤٣٦ هـ.
- قوانين الأصول للميرزا القمي O ، القرص الليزري.
- الكافي: لثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني S, دار الكتب الإسلاميّة.
- كامل الزيارات لأبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمي S, تحقيق جواد القيّومي.
- المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي O, القرص الليزري للمكتبة الشاملة.
- معجم رجال الحديث للسيد أبو القاسم الخوئي S, الطبعة الأولى مطبعة الآداب ـ النجف.
- وسائل الشيعة للحر العاملي O, تحقيق مؤسسة آل البيت iلإحياء التراث.
(١) تعارض الأدلّة واختلاف الحديث: ١/ ٢٣٧.
(٢) الحدائق: ١/٥.
(٣) تعارض الأدلّة واختلاف الحديث: ١/٢٣٧.
(٤) المصدر السابق: ١/ ٢٤٣ ـ ٢٤٥.
(٥) المصدر السابق: ١/ ٢٢٥.
(٦) المحاسن: ٢/٢٩٩-٣٠٠.
(٧) يلاحظ رجال النجاشي: ٧٦, والفهرست: ٦٢.
(٨) رجال ابن الغضائري: ٣٩.
(٩) يلاحظ الأبواب (رجال الشيخ) : ٣٦٣.
(١٠) يلاحظ رجال النجاشي: ٣٣٥.
(١١) رجال ابن الغضائري: ٩٣.
(١٢) رجال النجاشي: ٢٧٤.
(١٣) يلاحظ الفهرست: ١٦٨.
(١٤) رجال النجاشي: ٢١٤.
(١٥) جوابات أهل الموصل: ٢٥.
(١٦) اختيار معرفة الرجال: ٣١٦.
(١٧) يلاحظ جوابات أهل الموصل: ٢٥.
(١٨) يلاحظ القبسات: ٢/٢٥.
(١٩) التهذيب: ٣/ ١٣, باب العمل في ليلة الجمعة ويومها, ح٤٦.
(٢٠) الكافي: ٣/٢٧٤, باب المواقيت أولها وآخرها, ح٢.
(٢١) بحوث في شرح مناسك الحج: ١٠/ ١٨٢.
(٢٢) الاستبصار: ١/ ٢٥٦, باب من صلّى في غير الوقت, ح٤٥.
(٢٣) قرب الإسناد: ١٦٤, ٦٠١.
(٢٤) الكافي: ٣/٢٧٦, باب في وقت الظهر والعصر, ح٤.
(٢٥) التهذيب: ٢/٢٦, باب أوقات الصلاة, ح٢٤.
(٢٦) المصدر السابق: ٢/٢٠, باب أوقات الصلاة, ح٦.
(٢٧) المصدر السابق: ٢/١٩, باب أوقات الصلاة, ح٢.
(٢٨) رجال النجاشي: ٣٩٩.
(٢٩) الفهرست: ٢٣٨.
(٣٠) رجال النجاشي: ١٢٣.
(٣١) المصدر والموضع السابق.
(٣٢) رجال النجاشي: ٣٨٩.
(٣٣) المصدر السابق: ٢٦١.
(٣٤) المصدر السابق: ١٧٧.
(٣٥) يُلاحظ المصدر السابق: ٣٤٨.
(٣٦) الكافي: ٣:٢٧٧, باب وقت الظهر والعصر, ح٧.
(٣٧) التهذيب: ٢/٢٤٩, باب ١٣ من المواقيت,ح٢٦.
(٣٨) رجال النجاشي: ٢٢٧.
(٣٩) الكافي: ٣/٢٧٦ـ٢٧٧, باب وقت الظهر والعصر, ح٦.
(٤٠) يلاحظ رجال النجاشي: ٣٧٧.
(٤١) المصدر السابق: ٣٥٣.
(٤٢) المصدر السابق: ٣٣٤.
(٤٣) المصدر السابق: ٢٣٦.
(٤٤) المصدر السابق: ١٨٨.
(٤٥) الفهرست: ١٤١.
(٤٦) يلاحظ بحوث في شرح مناسك الحجّ: ٣/٣٨٥.
(٤٧) اختيار معرفة الرجال: ٢٩٦.
(٤٨) قال العلّامة المجلسي في البحار: ٨٠/ ٤٢. (بيان: قوله g: (فإنّي قد حرقت) أقول: النسخ هنا مختلفة ، ففي بعضها بالحاء المهملة والفاء على بناء المجهول من التفعيل أي غيّرت عن هذا الرأي فإنّي أمرته بالتأخير لمصلحة، والآن قد تغيّرت المصلحة. ويؤيده أنّ في بعض النّسخ (صرفت) بالصاد المهملة بهذا المعنى، وفي بعضها بالحاء والقاف كناية عن شدة التأثر والحزن، أي حزنت لفعله ذلك، وفي خبر آخر من أخبار زرارة (فحرجت) من الحرج، وهو الضيق. وعلى التقادير الظّاهر أنّ قول الراوي حتى تغيب الشمس مبني على المبالغة والمجاز، أي شارفت الغروب) .
(٤٩) جامع الأحاديث:٤/٢١٧, باب ١٠ من المواقيت, ح٧.
(٥٠) الكافي: ٣/٤٤٣, باب صلاة النوافل, ح٢.
(٥١) رجال النجاشي: ٢٦٠.
(٥٢) يلاحظ الفهرست: ٢١٨, ورجال النجاشي: ٣٢٦.
(٥٣) الفهرست: ١٨٤.
(٥٤) رجال النجاشي: ٢٨٣.
(٥٥) يلاحظ رجال الشيخ: ١٤٣, ورجال النجاشي: ٣٠٩.
(٥٦) الكافي: ٣/٤٤٦, باب صلاة النوافل, ح١٥.
(٥٧) يلاحظ التهذيب: ٧/١٠١, باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك, ح٤٣٥, والاستبصار: ١/٤٠, باب البئر تقع فيه الفأرة, ح١١٢, والاستبصار: ٣/٩٧, باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة, ح٣٢٥.
(٥٨) الكافي: ٣/ ٤٤٣ ح٥ باب صلاة النوافل.
(٥٩) يلاحظ رجال الشيخ: ٣٦٤, ورجال النجاشي:٣٣٠.
(٦٠) يلاحظ الفهرست: ١١٩.
(٦١) التهذيب: ٢/٥, باب المسنون من الصلوات, ح٨.
(٦٢) يلاحظ الفهرست: ١١٢.
(٦٣) يلاحظ العدة: ١/١٥٠.
(٦٤) قبسات من علم الرجال: ١/٣٣٩.
(٦٥) يلاحظ الفهرست: ١٦٨, ورجال النجاشي: ٢١٤.
(٦٦) يلاحظ رجال النجاشي: ١٨٣.
(٦٧) التهذيب:٢/٦, باب المسنون من الصلوات, ح٩.
(٦٨) يلاحظ الفهرست: ٦٨, ورجال النجاشي: ٨٢.
(٦٩) يلاحظ رجال النجاشي: ٣٩.
(٧٠) المصدر السابق: ٢١٤.
(٧١) التهذيب:٢/٧.
(٧٢) يلاحظ الفهرست: ١٧٣.
(٧٣) يلاحظ رجال النجاشي: ١٧٥.
(٧٤) التهذيب: ٢/٧, باب المسنون من الصلوات, ح١٣.
(٧٥) الكافي: ٣/٤٤٣, باب صلاة النوافل, ح٤.
(٧٦) التهذيب: ٢/٦, باب المسنون من الصلوات, ح١١.
(٧٧) يلاحظ الفهرست: ١١٥, ورجال النجاشي: ١٤٢.
(٧٨) يلاحظ رجال النجاشي: ١٩٥.
(٧٩) المصدر السابق: ٤٤١.
(٨٠) الكافي: ٣/٤٤٤, باب صلاة النوافل, ح٨.
(٨١) يلاحظ رجال ابن الغضائري: ٦٨.
(٨٢) يلاحظ رجال النجاشي: ١٨٥.
(٨٣) يلاحظ الفهرست: ١٤٢.
(٨٤) هذا هو الصحيح وهو يوافق ما في الاستبصار: ١/ ٢١٨، والموجود في التهذيب (أحد) .
(٨٥) التهذيب: ٢/٣, باب المسنون من الصلوات, ح١.
(٨٦) يلاحظ رجال النجاشي: ٣٤٨.
(٨٧) يلاحظ الفهرست: ٢٢١.
(٨٨) يلاحظ رجال النجاشي: ٣٣٣.
(٨٩) يلاحظ المصدر السابق: ٤٤٧.
(٩٠) يلاحظ رجال الشيخ: ٣٤٦.
(٩١) يلاحظ المصدر السابق: ٣٥٢.
(٩٢) هذا هو الصحيح والموافق لما في الاستبصار: ١/ ٢١٩، وفي التهذيب (ستة) .
(٩٣) التهذيب: ٢/٦, باب المسنون من الصلوات, ح١٠.
(٩٤) التهذيب: ٢/ ١١.
(٩٥) رجال النجاشي: ١٧٧.
(٩٦) المصدر السابق: ٤١٢.
(٩٧) المصدر السابق: ٤٢١.
(٩٨) اختيار معرفة الرجال: ١/ ٣٤٩ ـ ٣٥٢ ح٢٢١.
(٩٩) رجال النجاشي: ٣٧٢.
(١٠٠) الفهرست: ٢١٧.
(١٠١) رجال الشيخ: ٤٢١.
(١٠٢) رجال النجاشي: ٣٣٣.
(١٠٣) المصدر السابق: ١٢٣.
(١٠٤) المصدر السابق: ٤٣٨.
(١٠٥) المصدر السابق: ٣٦.
(١٠٦) التهذيب: ٥/٤٢٦, باب٢٦ الزيادات في فقه الحجّ, ح١٢٦.
(١٠٧) يلاحظ رجال النجاشي: ٤٢٠.
(١٠٨) التهذيب: ٥/٤٢٦, باب٢٦ الزيادات في فقه الحج, ح١٢٧.
(١٠٩) رجال النجاشي: ٣٤٩.
(١١٠) رجال الشيخ: ٣٩١.
(١١١) رجال النجاشي: ٢٣٧.
(١١٢) التهذيب: ٥/٤٢٩, باب٢٦ الزيادات في فقه الحجّ, ح١٣٦.
(١١٣) قبسات من علم الرجال: ١/٢١٤.
(١١٤) التهذيب: ٥/ ٤٢٨.
(١١٥) رجال الشيخ: ٣٦٥, ورجال النجاشي: ٤٠٥.
(١١٦) رجال النجاشي: ٢٣٥.
(١١٧) المصدر السابق: ٢٣٥.
(١١٨) الكافي:٤/٥٢٤, باب إتمام الصلاة في الحرمين, ح٢٠.
(١١٩) الكافي: ٤/٥٢٥, باب إتمام الصلاة في الحرمين, ح٨.
(١٢٠) الفهرست: ١٥٢, ورجال النجاشي: ٢٥٣.
(١٢١) التهذيب:٥/٤٢٥, باب ٢٦ الزيادات في فقه الحجّ, ح١٢٢.
(١٢٢) المصدر السابق: ٥/٤٢٦, باب٢٦ الزيادات في فقه الحجّ, ١٢٥.
(١٢٣) المصدر السابق: ٥/٤٢٦, باب٢٦ الزيادات في فقه الحجّ, ح١٢٨.
(١٢٤) المصدر السابق: ٥/٤٢٦, باب٢٦ الزيادات في فقه الحجّ, ح ١٢٩.
(١٢٥) كامل الزيارات: باب ٨١, التقصير في الفريضة والرخصة في التطوع, ح٩.
(١٢٦) رجال النجاشي:١٢٣.
(١٢٧) المصدر السابق: ١٠٢.
(١٢٨) التهذيب: ٥/٤٣٠, باب٢٦ الزيادات في فقه الحجّ, ح١٣٧.
(١٢٩) الفهرست: ١٥١.
(١٣٠) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ٢/٢٤٧ـ ٢٤٨.
(١٣١) يلاحظ القبسات: ١/ ٢٣.
(١٣٢) خلاصة الأقوال: ٣٣٧ــ ٣٣٨.
(١٣٣) التهذيب: ٥/٤٣٠, باب من الزيادات في فقه الحج, ح١٣٨.
(١٣٤) يلاحظ رجال الشيخ: ٣٣٨, ورجال النجاشي: ١٧٨.
(١٣٥) يلاحظ الفهرست: ١٥٤.
(١٣٦) التهذيب:٥/٤٢٩, باب٢٦ الزيادات في فقه الحجّ, ح١٣٤.
(١٣٧) التهذيب: ٥/ ٨٧, باب٧ صفة الإحرام, ح٩٧.
(١٣٨) يلاحظ الفهرست: ١١٨.
(١٣٩) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) : ١/ ٣٨٢ ح٢٧٠.
(١٤٠) التهذيب: ٥/ ٨٧, باب٧ صفة الإحرام, ح٩٨.
(١٤١) رجال النجاشي: ١٢٦.
(١٤٢) المصدر السابق: ٢٣٥.
(١٤٣) المصدر السابق: ٣٥٩.
(١٤٤) رجال الشيخ: ١٢٤.
(١٤٥) رجال النجاشي: ١١٠.
(١٤٦) التهذيب: ٥/ ٨٦, باب٧ صفة الإحرام, ح٩٢.
(١٤٧) المصدر السابق: ٢/٨٨, باب٧ صفة الإحرام, ح١٠٠.
(١٤٨) المصدر السابق: ٦/ ٨٦, باب٧ صفة الإحرام, ح٩١.
(١٤٩) المصدر السابق: ٥/٨٦, باب ٧ صفة الإحرام, ح٩٣.
(١٥٠) المصدر السابق: ٥/٨٥, باب٧ صفة الإحرام, ح٩٠.
(١٥١) يلاحظ رجال النجاشي:٢٣٠.
(١٥٢) التهذيب: ٢/٨٨, باب٧ صفة الإحرام, ح٩٩.
(١٥٣) يلاحظ رجال النجاشي: ٤٥٠.
(١٥٤) التهذيب: ٥/٨٧, باب٧ صفة الإحرام, ح٩٤.
(١٥٥) يلاحظ رجال النجاشي: ٤٩.
(١٥٦) يلاحظ رجال الشيخ: ٣٤٢, ورجال النجاشي: ٣١٠.
(١٥٧) يلاحظ الفهرست: ١٢٩, ورجال النجاشي: ١٦٦.
(١٥٨) يلاحظ المصدر السابق: ٥٧.
(١٥٩) التهذيب:٥/٨٧, باب٧ صفة الإحرام, ح٩٥.
(١٦٠) يلاحظ رجال النجاشي: ١٨٩، والفهرست: ١٤٠.
(١٦١) يلاحظ الفهرست: ١٢٩.
(١٦٢) يلاحظ رجال النجاشي: ٣١٤.
(١٦٣) وسائل الشيعة: ٤/٦١.
(١٦٤) بحوث في شرح مناسك الحجّ: ١٠/ ١٨٥.
(١٦٥) التهذيب: ٥/٣٩١, باب٢٦ الزيادات في فقه الحجّ, ح١٢.
(١٦٦) الكافي: ٤/ ٤٤٦, باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك, ح٢.
(١٦٧) التهذيب: ٥/ ٣٩٠, باب٢٦ الزيادات في فقه الحجّ, ح٩.
(١٦٨) يلاحظ رجال الشيخ:٣٤٢, ورجال النجاشي: ٣١٠.
(١٦٩) التهذيب: ٥/ ٣٩١, باب٢٦ الزيادات في فقه الحجّ, ح١٢.
(١٧٠) تهذيب الأحكام: ٥/ ١٧٢, باب١١ الإحرام للحجّ, ح٢٠.
(١٧١) رجال النجاشي: ٣٠٢.
(١٧٢) بحوث في شرح مناسك الحج: ١٠/ ١٤٣.
(١٧٣) التهذيب: ٥/١٧٢,باب الإحرام للحج, ح ٢١.
(١٧٤) رجال النجاشي: ٣٦٧.
(١٧٥) الفهرست: ٢٢٥.
(١٧٦) رجال النجاشي: ١٨٦.
(١٧٧) المصدر السابق: ٧٣.
(١٧٨) التهذيب: ٥/ ١٧٢, باب الإحرام للحجّ, ح١٩.
(١٧٩) معجم رجال الحديث: ١١/ ١٨٠.
(١٨٠) رجال النجاشي: ٢٩٨.
(١٨١) المصدر السابق: ٣٢٣.
(١٨٢) بحوث في شرح مناسك الحج: ١٠/ ١٤٥.
(١٨٣) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: ٢/ ٢٤٦.
(١٨٤) التهذيب: ٥/ ١٧٠, باب١١ الإحرام للحجّ, ح١١.
(١٨٥) معجم رجال الحديث: ١٤/ ٣٠٤.
(١٨٦) رجال النجاشي: ٢٣٠.
(١٨٧) التهذيب: ٥/: ١٧١, باب١١ الإحرام للحجّ, ح١٣.
(١٨٨) يلاحظ رجال النجاشي: ٤٢٤.
(١٨٩) الكافي: ٤/ ٤٤٣, باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة, ح١.
(١٩٠) رجال النجاشي: ٤٣٤.
(١٩١) المصدر السابق: ١٩٥.
(١٩٢) بحوث في شرح مناسك الحج: ١٠/ ١٥٠.
(١٩٣) التهذيب: ٢/١٧١, باب١ الإحرام للحجّ, ح١٥.
(١٩٤) بحوث في شرح مناسك الحج: ١٠/ ١٥٣.
(١٩٥) التهذيب: ٥/ ١٧٤, باب١١ الإحرام للحجّ, ح٣٠.
(١٩٦) يلاحظ بحوث في شرح مناسك الحج: ١٠/ ١٦٠.










